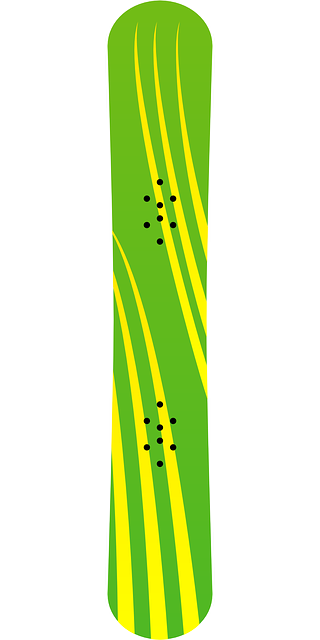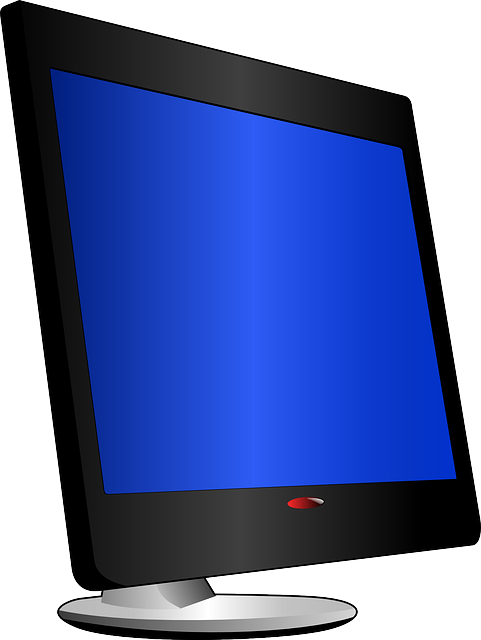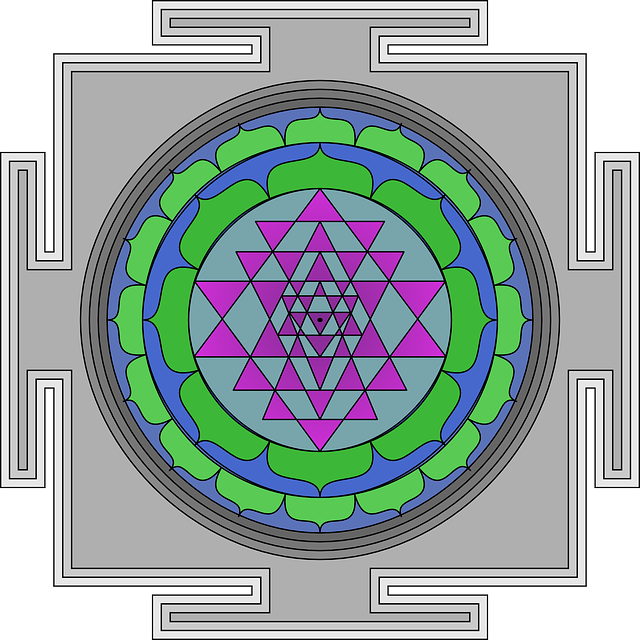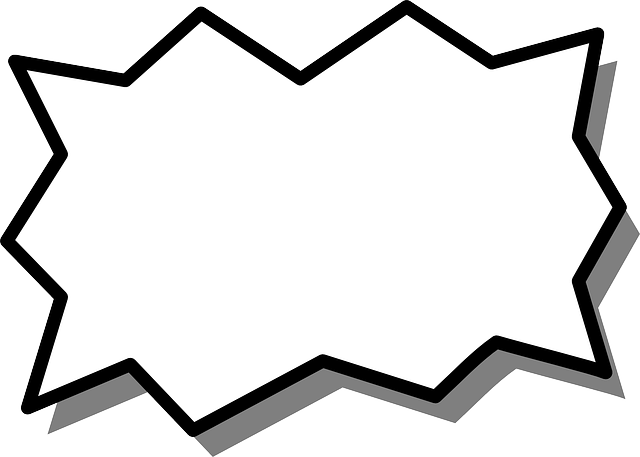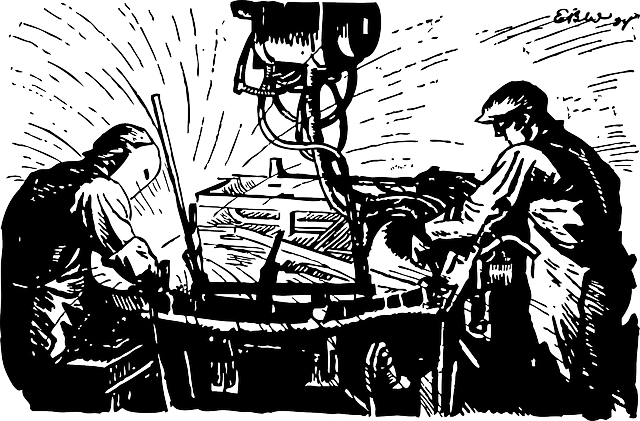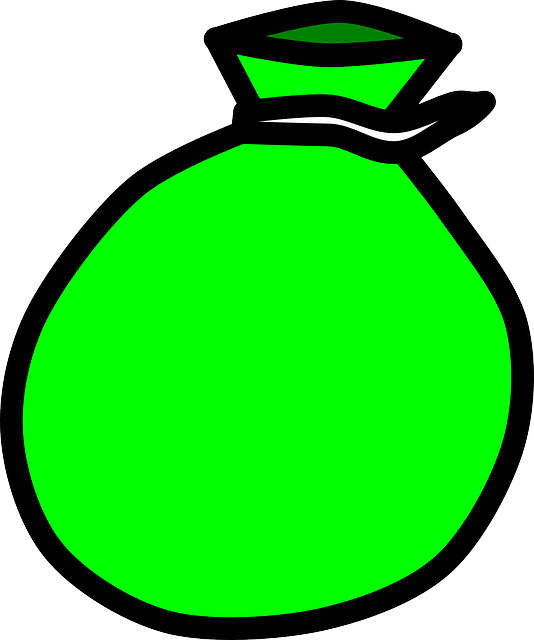التفكير في النص القرآني، وشرحه وتفسيره وحصر معناه، ليس انشغالا عربيا، فقد دأب المستشرقون، ومعهم الدارسون القرآنيون، على محاولة تفكيك الخطاب القرآني وارتياد علومه ومباحثه ولغاته، وتحديد نوازله ومفاتيح فهمه، وذلك في مواجهة التيارات الدينية التي تحاول فرض أساليبها بمنطق استغلاقي واحتكاري وإيماني، لا يستقيم الآن مع تعدد المناهج وطرق البحث العلمية التي تنبني على التشخيص والتحليل والتدقيق والتمحيص واستدعاء القرائن العلمية المادية والتاريخية.
القرآن، النّص المؤسّس للدّين الإسلامي أو دستور النّظام الإسلامي، منذ «نزوله» وإلى يومنا هذا، ظلّ وما زال متأرجحا بين محاولات الفهم الحرفي الضّيّق المنغلق من جهة… بين من فطنوا إلى أنّ الإسلام صيرورة تاريخيّة اجتماعيّة تحمل مفاتيحها في انفتاح دلالات ومعاني نصوصه الأصليّة وأوّلها القرآن، وبين من سلّموا وتصوّروا أنّ الإسلام هو الواقعة التّاريخيّة الأولى للوحي، ونبّهوا إلى أنّ انفتاحها وتحوّلاتها محض ضلال وانحراف وتزييف يجب الخلاص منه…
هكذا ظلّ القرآن، ومعه النّصوص الأصليّة للإسلام، متأرجحة جميعها بين فقهاء متزمّتين وفلاسفة معتدلين، بين المعتزلين والعلمانيّين من جهة وبين فتاوى المؤسّسات الدّينيّة الرّسميّة التي أجادت تبرير انتهاكات الخلافة والسّلطان والحاكم، بدءا من فقهاء البلاط وصولا إلى شيوخ القنوات التّلفزيّة…
ظل القرآن متجاذبا بين نقل وعقل، منذ أن زعم الشّيعة أنّ «مصحف عثمان» قد مُحيت منه عمدا كلّ النّصوص الدّالة على إمامة علي وعلى فضل أهل البيت على العرب وكافّة النّاس… ومرورا بالنّسق الأشعري الكلامي والصّوفي العرفانيّ والفلسفي الإشراقي والإيديولوجيا الغزاليّة، وصولا إلى حسن البنّا وسيّد قطب ومحمّد عمارة والقرضاوي من جهة، وبين النّسق الاعتزالي الكلامي والنّسق الفلسفي العقلي، بدءا من ابن رشد والفارابي وابن الرّاوندي، ومرورا بعليّ عبد الرّازق وطه حسين وزكي نجيب محمود ومحمود أمين العالم، وصولا إلى خليل عبد الكريم ونصر حامد أبو زيد وهشام جعيّط وقاسم أمين والطّاهر الحدّاد ومحمّد الطّالبي…
في هذا النّسق العقلاني يمكننا أن ندرج كتاب الفيلسوف التنويريّ والباحث الأنثروبولوجيّ التّونسي يوسف الصّدّيق « لم نقرأ القرآن أبدا» الصّادر باللّغة الفرنسيّة «Nous n’avons jamais lu le coran» وذلك لما تميّزت به فصوله الخمسة من آليّات الإقناع والحفز المعرفي، المتعالية عن السّرديّة الوعظيّة الإنشائيّة والتّوتّر المعرفي… فصول خمسة اخترق يوسف الصّدّيق، من خلال متونها، أهمّ التّراكمات الدّلاليّة والسّيميائيْة التي تركتها القراءات التّراثيّة أو أنتجتها القراءات المعاصرة ذات الطّابع المدرسيّ…
… وكأنّ شيئا لم يكن… كتابٌ مُقلقٌ، مُستفزٌ، يُبعثر أفكارك جميعها ثمّ يسائلها فكرة فكرة، ليعيد ترتيبها خارج التّقسيم المكّي والمدينيّ لسور القرآن. لديه مطرقة الجينيالوجيّ تبحث في السّلالة الأولى للكلمة وللفكرة… وأنف الأركيولوجيّ يميّز به الأحجار وفقَ رائحتهَا ويُموقعُها في أزمان غوايَة النَّص.
كتاب يُعلن فيه صاحبه يوسف الصّدّيق جازمًا أنّنا لم نقرأ القرآن أبدًا، و»يُذنّبُنَا» جميعا، ودون استثناء، لأنّنا لم نقرأ القرآن، وكأنّ شيئا لم يًكنْ، نقرأ وكأنّ العهود الأولى للإسلام المؤسّسَاتي، لا تَحُولُ بمؤسّساتها بيننا وبين القرآن. هذا النّص ذو القارئ التّاريخيّ اللاّمُحدّد زمانا ومكانا، نُغفلُ أن فعل «اِقرأ» الذي أعلن ذات يوم من سنة ميلادية نزول الوحي على ابن الأربعين حولا ـ محمّد ـ نزل على شخص يجهلُ فعلَ القراءَة، هكذا على الأقلّ تروي كُتبُ السّيرة ومجلّداتها، لنا الحكاية، أو بهذا السّيناريو تريد أن تُقنعَنَا، بعد أن طمست وتجاهلت «أمجاد الآلهة التي سبقت الإسلام» وأتلفت «إمام حفصة”…
تبدأ الحكاية في غار حرَاء في قلب الجبال والوتَاد المحيطَة بمكَّةَ، لنُصدّقَ ـ ولو لحين ـ هذه الفرضيّة ولْنَقُلْ أن المَلاكَ المُقْرئَ قد طلب من محمّد أن يقرأ وأعاد عليه طلبه ثلاَثا، فأجابَ «ما أنا بقَارئ». ولكن، لنسأل أيضًا كيف يُمكنُ أن يكون جبريل، ملاكُ السّماء والرّسول إلى الرّسُول، على غير علم بأنّ محمّد لا يعرف القراءَة ويجهل حروفها وحركاتها وسكناتها!!!. كأنّه أدرك تلك الحقيقة عن طريق محمّد، فكان أن وجّهَ له خطابه نحو الإقرار بربّه على نحو يردّدُ فيه محمّد ما يُمليه عليه الوحيُ مُؤمنا ومُسلّمًا دون جدال أو مساءلة!!! هكذا اقتصر دور الرّسُول على كونه المُرَدِّد والمُلَقِّن لهذه الآية الفاتحة، وصار لفعل الأمر «اِقرأ» دلالة التّلقين لا غير.
علينا أن ننطلقَ من فرضيّات أخرى تُعيدُ قراءَة موروث مُؤسَّسة النّقل وفقَ القواعد النّحويّة والبلاغيّة والإعراب والتَّنْقيط، مثلمَا حُدّدت قرنين بعد نُزُول القرآن عن طريق المشافهة.
هذا الكتاب «ينوي» مساءلة النّص المُتعالي، المتن الذي خان صاحبه وصار نصَّ المُؤسّسة ومتنها. كتاب «ينوي» طرح الإحراجات ومُجادلة مدرسة النّقْل لأنّه كتاب يتموقع ضمن تصوّر فلسفيّ، يُراجع الصّيرورة التّاريخيّة لمُنْجَز تُقدّمه كتب السّيرة على أنّه فعلاً مُنته للأحداث ومُسْتَوْف للفهم… لفيلسوف يحتفظ «بالتّفسير الملتبس» ويلتزم» بمضادات العقل». يستند هذا الكتاب في مادّته الأوليّة على الخطاب القرآنيّ، تماما مثلما نقله رجلٌ يُشاعُ أنّهُ رجلٌ عاديٌ تلقّى «الهَاتفَ»، فأكّد أنّه ذو مصدر إلاهيّ. لكنّ قراءة هذا النّص ـ الذي لم يُسمع مثله من قبل ولا من بعد ـ تستوجب قراءة الحوافّ المحيطة به، وإدراك الظّروف التّاريخيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة للقارئ الذي نزل عليه النّص وتوجّه إليه في تلك اللّحظة التّاريخيّة الفارقة. كيف يُمكنُ أن نقرأ اليوم هذا النّص؟ وكيف يمكن أن نُقيّم دور المحيطين بالرّسول أنْصارا وأضدادا، مُشيّعين ومُخالفين؟ كيف السّبيل إلى هذه القراءة بالأدوات المعرفيّة التي نملك اليوم؟…