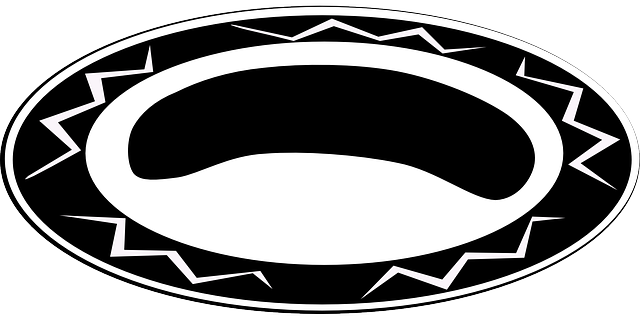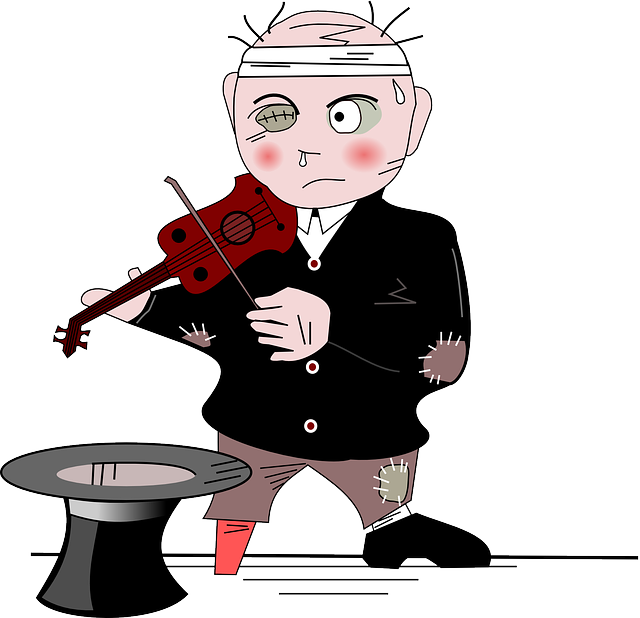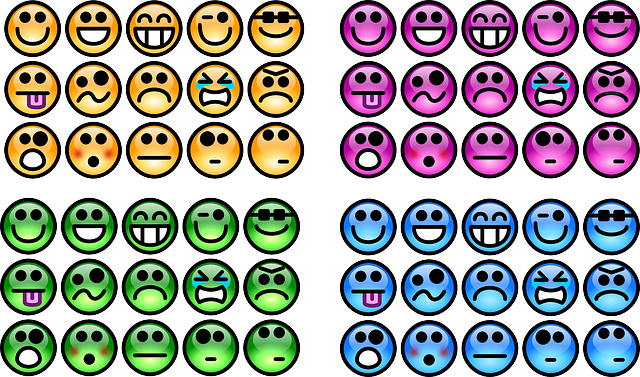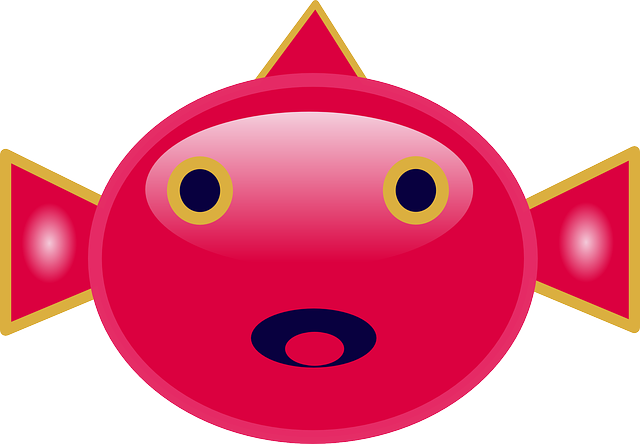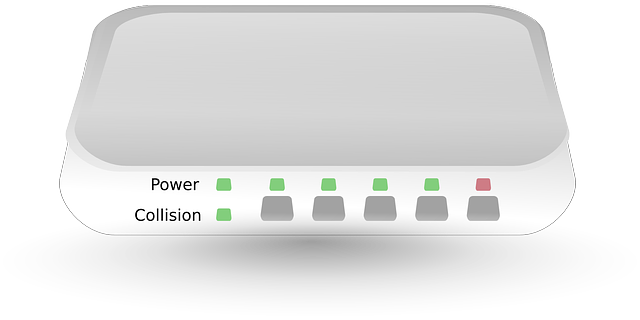عÙد٠ا ØصÙت اÙبÙاد اÙتÙÙسÙØ© عÙ٠استÙÙاÙÙا عا٠1956Ø ÙاÙت اÙجارة اÙغربÙØ© اÙجزائر Ùا تزا٠تÙاÙÙ Ùترص٠صÙÙÙÙØ§Ø ÙدØر ÙÙات اÙاØتÙا٠اÙÙرÙس٠ع٠ترابÙا. ÙÙاÙت اÙدÙعت Ù٠تÙ٠اÙأثÙاء Ø«Ùرة تØرÙرÙØ© اÙØ·ÙÙت شرارتÙا اÙØ£ÙÙ٠عا٠1954Ø Ùا٠تد٠ÙÙÙبÙا بعد Ø°Ù٠إÙ٠أغÙب اÙ٠د٠ÙاÙÙ Ùاط٠اÙجزائرÙØ©Ø Ùشار٠ÙÙÙا عدد ÙبÙر ٠٠اÙÙ ÙاÙÙ ÙÙ ÙاÙÙ ÙاضÙÙÙØ ÙÙبÙدت ÙÙÙا اÙاØتÙا٠اÙÙرÙس٠ÙØ«Ùرا٠٠٠اÙخسائر.
ÙØ¥Ù٠جاÙب اÙدع٠ÙاÙتأÙÙد اÙدÙÙ٠اÙØ°Ù ÙاÙت٠ثÙرة اÙتØرÙر اÙجزائرÙØ© Ù٠اÙÙ ØاÙ٠اÙدÙÙÙØ© Ù ÙØ° ٠ؤت٠ر باÙدÙÙغ Ø¥ÙدÙÙÙسÙا عا٠1955Ø ÙØ®Ùا٠اÙ٠ؤت٠رات اÙØ¢ÙرÙ-آسÙÙÙØ©Ø ØظÙت Ø£Ùضا٠ب٠ساÙدة Ùدع٠٠٠اÙبÙدا٠اÙØ´ÙÙÙØ© اÙت٠ÙاÙت تؤ٠٠بÙØدة اÙ٠صÙر ÙبÙØدة اÙØ¯Ù Ø§Ø¡Ø Ù٠٠بÙÙÙا تÙÙØ³Ø Ø§Ùت٠ÙÙرت ٠دÙÙا ÙÙراÙا اÙÙ ØاذÙØ© ÙÙجزائر اÙدع٠ÙÙÙ ÙاÙÙ ÙÙØ ÙÙا٠ذÙ٠سبب غضب اÙÙ ØتÙ٠اÙÙرÙس٠اÙØ°Ù Ø´Ù٠عÙÙÙا ÙجÙ٠ا٠٠سÙÙÙØاÙØ Ø¯ÙÙÙ٠تارÙخا٠٠شترÙÙا٠بÙ٠اÙشعبÙ٠اÙØ´ÙÙÙÙÙ.
ساÙÙØ© سÙد٠ÙÙسÙ.. ر٠ز ÙÙÙضا٠اÙ٠شترÙ
اÙØ·ÙاÙا٠٠٠ÙÙرت٠بأ٠"اÙجزائر ÙرÙسÙØ©"Ø Ùبعد ÙØ´Ù Ù٠خطط٠ÙÙ ÙاÙرات٠Ùإخ٠اد ÙÙÙب اÙØ«Ùرة اÙجزائرÙØ©Ø Ø±Ùع اÙجÙرا٠اÙÙرÙس٠شار٠دÙغÙ٠٠عد٠اÙتجÙÙد Ù٠صÙÙ٠اÙجÙØ´ اÙÙرÙسÙØ ÙØ·Ùب اÙدع٠اÙدÙÙÙ ÙتطÙÙ٠اÙØ«Ùار ÙدÙ٠٠عاÙÙÙÙ .
Ùأصدر ÙÙ Ø°Ù٠اÙÙÙت ÙاÙÙÙ ÙÙض٠ب٠ÙاØÙØ© عÙاصر جÙØ´ اÙتØرÙر اÙÙØ·Ù٠اÙجزائر٠أÙÙ٠ا ÙاÙÙا.
Ù٠ع اشتداد اÙÙ ÙاجÙات بÙ٠اÙطرÙÙÙ ÙتØت ÙرÙØ© ساÙÙØ© سÙد٠ÙÙس٠اÙتÙÙسÙØ©Ø Ø£Ø¨ÙابÙا ÙÙجرØÙ ÙاÙ٠صابÙ٠٠٠عÙاصر جÙØ´ اÙتØرÙر اÙØ°Ù٠استخد٠Ùا بدÙرÙ٠اÙ٠دÙÙØ© Ù ÙØ·Ùة٠استراتÙجÙØ©Ù ÙÙØدات اÙجÙØ´ ÙÙاعدة Ø®ÙÙÙØ© ÙÙعÙØ§Ø¬Ø Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© Ø¥Ù٠استÙبا٠اÙÙاجئÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙاÙÙا ÙتÙاÙدÙÙ ÙÙØصÙ٠عÙ٠٠ساعدات اÙÙÙا٠اÙØ£Ø٠ر ÙاÙصÙÙب اÙØ£ØÙ Ø±Ø Ù٠ظ٠اÙظرÙ٠اÙ٠أساÙÙØ© اÙت٠ÙاÙت ت٠ر بÙا اÙبÙاد تØت ÙÙرا٠اÙاØتÙا٠ÙÙ٠عÙ.
ÙتÙتسب اÙساÙÙØ© Ø£ÙÙ ÙØ© Ùبر٠اÙØ·ÙاÙا٠٠٠٠ÙÙعÙا اÙاستراتÙج٠عÙ٠اÙØدÙد اÙ٠شترÙØ© بÙ٠اÙبÙدÙÙØ Ø¹Ù٠اÙطرÙ٠اÙ٠ؤدÙ٠٠٠٠دÙÙØ© سÙ٠أÙراس باÙجزائر Ø¥Ù٠٠دÙÙØ© اÙÙا٠بتÙÙØ³Ø ÙÙÙ ÙرÙبة بذÙ٠جدا٠٠٠٠دÙÙØ© ÙØدادة اÙجزائرÙØ© اÙتابعة إدارÙا٠ÙÙÙاÙØ© سÙ٠أÙراس.
ÙأصبØت اÙ٠دÙÙØ© بذÙÙ Ù٠٠ر٠٠اÙاستÙدا٠اÙ٠ست٠ر ÙÙÙات اÙاØتÙا٠اÙÙرÙسÙØ Ø§Ùت٠شÙÙت عÙÙÙا ÙجÙ٠ا٠٠سÙØا٠Ù٠أÙثر Ù Ù Ù ÙØ§Ø³Ø¨Ø©Ø Ø¹Ùابا٠عÙ٠٠ساÙدتÙا جÙØ´ اÙتØرÙر ÙتعبÙرÙا ع٠تضا٠ÙÙا Ùدع٠Ùا ÙÙØ«Ùرة اÙجزائرÙØ©Ø Ø§Ùت٠تÙدد ÙÙÙØ° ÙÙجÙد ÙرÙسا Ù٠اÙØ¬Ø²Ø§Ø¦Ø±Ø Ø¥Øد٠أÙ٠٠ستع٠راتÙا.
ÙÙا٠أÙÙ ÙجÙ٠٠سÙØ ØªØ¹Ø±Ø¶Øª Ù٠اÙساÙÙØ© Ù٠سÙا٠٠ÙاØÙØ© عÙاصر جÙØ´ اÙتØرÙر اÙÙØ·ÙÙØ ÙÙÙ Ù 1 Ù2 Ø£ÙتÙبر/تشرÙ٠اÙØ£ÙÙ 1957. تÙا٠ÙجÙ٠ثاÙÙ ÙÙÙ 30 ÙÙاÙر/ÙاÙÙ٠اÙثاÙÙ 1958Ø Ø¨Ø¹Ø¯ أ٠تعرضت طائرة ÙرÙسÙØ© ÙÙÙرا٠جÙØ´ اÙتØرÙر اÙÙØ·ÙÙ.
ÙÙا٠اÙÙجÙ٠ا٠ت٠ÙÙدا٠Ù٠جزرة Ø£Ùبر Ùأبشع سÙÙÙ ÙÙÙا ÙØ«Ùر ٠٠اÙØ¯Ù Ø§Ø¡Ø ÙبÙÙت شاÙدة عÙÙ ÙØØ´ÙØ© اÙاØتÙاÙ.
Ø£Øداث ساÙÙØ© سÙد٠ÙÙسÙ.. ٠جزرة ÙØØ´ÙØ©
أ٠ا٠اÙدع٠اÙÙبÙر اÙØ°Ù ØصÙت عÙÙ٠اÙØ«Ùرة اÙجزائرÙØ© ٠٠٠ختÙ٠اÙÙ ÙÙÙات اÙسÙاسÙØ© ÙاÙ٠دÙÙØ© Ù٠تÙÙس Ù٠٠عدÙد اÙÙ Ùاط٠اÙØدÙدÙØ© بÙ٠اÙبÙدÙÙØ Ùا٠Ùا بد ÙÙاØتÙا٠اÙÙرÙس٠٠٠اÙتخطÙØ· ÙÙجÙÙ ÙبÙر Ùسبب ÙÙ٠اÙÙØ·Ùعة بÙ٠اÙشعبÙÙ ÙÙدÙع اÙتÙÙسÙÙ٠إÙ٠اÙتخÙ٠ع٠دع٠ثÙرة اÙتØرÙر.
ÙÙجÙÙÙت ÙÙرا٠اÙÙ ØتÙÙ Ù٠داÙع٠ÙÙÙ 8 ÙبراÙر/شباط 1958 ÙØ٠ساÙÙØ© سÙد٠ÙÙس٠اÙتÙÙسÙØ© اÙØدÙدÙØ©Ø Ø§Ùت٠تÙعÙد٠أØد Ø£Ù٠٠اÙ٠عاÙ٠اÙت٠اØتضÙت اÙØ«Ùار اÙجزائرÙÙÙ.
ÙÙÙ ÙÙ٠اختÙار Ø°Ù٠اÙتارÙØ® ÙØ´Ù٠اÙÙجÙ٠اعتباطاÙØ Ø¥Ø° صاد٠ذÙÙ ÙÙ٠اÙسÙ٠اÙأسبÙعÙØ© Ù٠اÙ٠دÙÙØ©Ø Ø§Ùت٠ÙØتشد ÙÙÙا عدد ÙبÙر ٠٠اÙ٠دÙÙÙ٠اÙتÙÙسÙÙÙØ ÙÙتÙاÙد Ø¥ÙÙÙا عدد ÙبÙر ٠٠اÙجزائرÙÙÙ ÙتسÙ٠اÙ٠ساعدات ÙاÙ٠عÙÙات اÙغذائÙØ© ٠٠اÙÙ Ùظ٠ات.
Ù٠ع ØÙÙ٠اÙساعات اÙØ£ÙÙÙ Ù Ù ØµØ¨Ø§Ø Ø°Ù٠اÙÙÙÙ Ø ØºØ·Øª أسراب ٠٠اÙطائرات اÙÙاذÙØ© ÙاÙ٠طاردة س٠اء ساÙÙØ© سÙد٠ÙÙس٠ÙØ´ÙÙت غارات ÙÙصÙا٠٠تÙاصÙا٠است٠ر Ø£Ùثر ٠٠ساعة.
ÙاستÙد٠اÙÙصÙØ Øسب٠ا Ø°Ùرت ٠صادر تارÙØ®ÙØ©Ø Ù Ø¨Ø§ÙÙ ØÙÙÙ ÙØ© Ù٠دارس ابتدائÙØ© ÙعدÙدا٠٠٠اÙÙ ØÙات ÙاÙÙ Ùاز٠اÙت٠Ùا٠Ùشتب٠Ù٠إÙÙائÙا عÙاصر جÙØ´ اÙتØرÙر اÙÙØ·Ù٠اÙجزائرÙ.
ÙÙÙ٠إØصائÙات رس٠ÙØ©Ø Ø£Ø³Ùر اÙÙجÙ٠اÙذ٠ا٠تزجت ÙÙ٠د٠اء اÙشعبÙÙØ Ø¹Ù Ø³ÙÙØ· ÙØÙ 68 ÙتÙÙا٠بÙÙÙÙ 12 Ø·ÙÙا٠Ù9 ÙØ³Ø§Ø¡Ø Ø¥Ù٠جاÙب 87 جرÙØا٠٠٠اÙتÙÙسÙÙÙ ÙاÙجزائرÙÙÙ.
أثارت Ø£Øداث ساÙÙØ© سÙد٠ÙÙسÙØ Ø§Ùت٠ÙØ´Ùت ع٠ÙØØ´ÙØ© ÙÙ٠جÙØ© اÙ٠ستع٠ر اÙÙرÙسÙØ Ø¶Ø¬Ø© إعÙا٠ÙØ© دÙÙÙØ©Ø Ø£Ø¯Ø§ÙتÙا عÙÙ Ùطا٠Ùاسع.
ÙبÙÙ٠ا Ùا٠اÙÙ ØتÙ٠اÙÙرÙس٠Ùأ٠٠ردع اÙتÙÙسÙÙ٠ع٠دع٠اÙØ«Ùرة اÙجزائرÙØ©Ø Ù ÙÙ٠اÙØ«Ùرة بذÙ٠اÙÙجÙ٠٠٠دع٠دÙÙÙØ Ùإصرار ÙÙØ´ÙÙÙØ© اÙشرÙÙØ© عÙ٠تÙدÙ٠٠زÙد ٠٠اÙدع٠ÙÙا.
ÙÙÙØÙÙ٠اÙتÙÙسÙÙÙÙ ÙاÙجزائرÙÙÙ Ù ÙØ° Ø°Ù٠اÙÙÙت Ùذا اÙتارÙØ® اÙØ°Ù Ùا٠شاÙدا٠عÙ٠اÙتضا٠٠اÙ٠شتر٠بÙ٠اÙبÙدÙÙ ÙÙ Ù ÙاÙÙ Ø© اÙاستع٠ار اÙÙرÙسÙ.