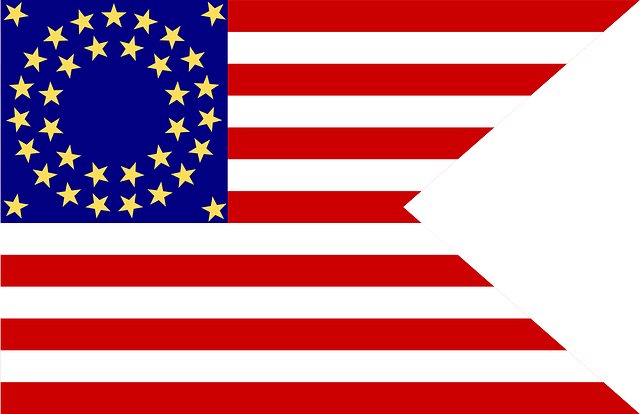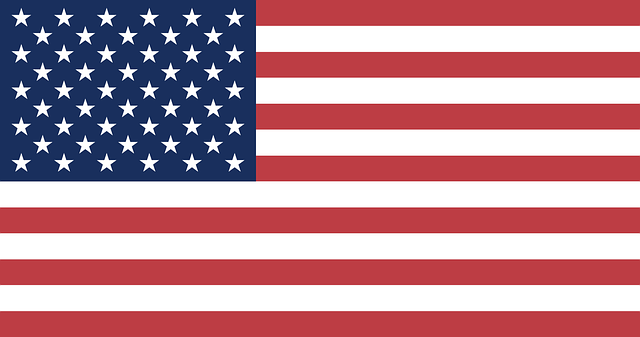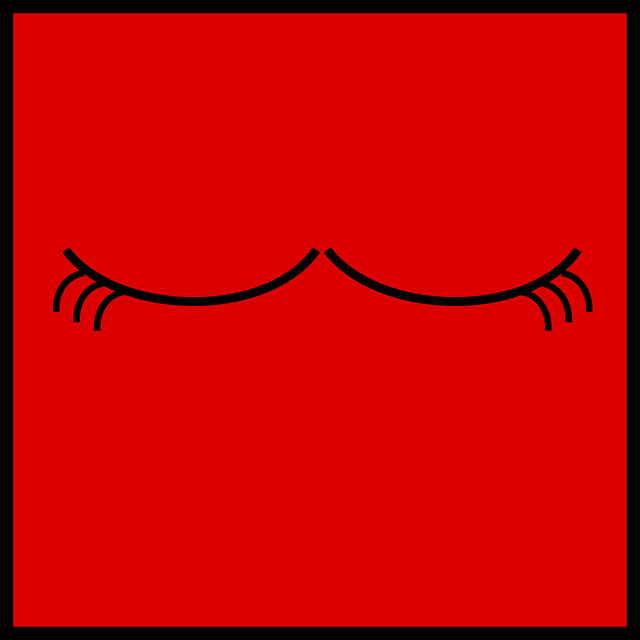تُعتبر الخلافات والمنافسات بين الحركات السياسية المدنية، أي غير الميلشيوية المسلحة، بمثابة أمر طبيعي، بل إنها ضرورية لخلق الديناميات اللازمة لإحداث التطور السياسي في تلك الحركات، ولتمثل حال التعددية في المجتمع، وللمفاضلة بين الخيارات السياسية المطروحة.
بيد أن الأمر في الحالة الفلسطينية خرج عن ذلك، إذ باتت هناك خلافات كثيرة ومتشعبة وصعبة جداً، وكلما استمرت ازدادت حدة، وتوسعت أكثر من ذي قبل، بالنظر لأسباب، يكمن أهمها في الآتي:
أولاً: إن ذلك الأمر يتعلق بشعب مجزّأ، ومشتّت، أصلاً، ويخضع لأنظمة متعددة، بمعنى أنه أحوج إلى الوحدة أو التوافق أكثر من أي شعب آخر، في حين أنه أكثر عرضة للأهواء المتضاربة، وضغوط الجغرافيا، وتقلبات السياسة، وحسابات الأنظمة.
ثانياً: لأن هذا الشعب يفتقد للكيان السياسي الجامع الذي يوحده، أو الذي تتم فيه، وتنتظم، التفاعلات السياسية، بالتوافقات أو الاختلافات، على نحو ما كانته منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. ومعلوم أن تلك المنظمة لم تعقد سوى ثلاث دورات لمجلسها الوطني (الـ 21 والـ 22 والـ 23 في الأعوام 1996 و2009 و2018)، أي طوال ثلاثة عقود، في حين يفترض عقد دورة واحدة كل سنة. وفي المحصلة فقد باتت المنظمة على الهامش، إذ إن السلطة أضحت هي مركز القيادة الفلسطينية من الناحية العملية، ناهيك بأن المنظمة فقدت جزءاً مهماً من شرعيتها بعد إزاحة قضية اللاجئين وتهميش دورهم في التفاعلات الفلسطينية.
ثالثاً: تعاني الكيانات السياسية الفلسطينية من ضعف مبناها المؤسساتي والديموقراطي، فهي كيانات بطركية على الأغلب، وتفتقد للحراكات الداخلية، والتداول على القيادة (الأمين العام للجبهة الديموقراطية بقي في منصبه منذ إنشاء الجبهة في العام 1969 حتى الآن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو في اللجنة المركزية لـ"فتح" منذ انطلاقتها في العام 1965). يفاقم من ذلك أن تلك الكيانات لا تعتمد في تمويل مواردها على شعبها أو على منتسبيها، وإنما على داعمين خارجيين، دولتيين، علماً أن الدول ليست جمعيات خيرية، أو جمعيات حقوق إنسان، أو نواديَ للتعارف.
بيد إنه رغم تشعب الخلافات، والانقسامات، والتنافسات، في الحركة الوطنية الفلسطينية، إلا أن ثمة ثلاثة جوانب ترسخ ذلك الانقسام وتصعّب إيجاد توافقات أو اجماعات سياسية.
الأول، يتعلق باختلاف الرواية الفلسطينية المشكلة للإجماع الوطني. ومعلوم أنه في بداية انطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة (1965)، والتي تأسست قبل احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة (1967)، لم يكن ثمة خلاف بين الفلسطينيين على حق العودة وتحرير فلسطين، على الرواية التي تأسست على حدث النكبة (1948)، بإقامة إسرائيل، وولادة مشكلة اللاجئين، بعد تشريد ثلثي الشعب الفلسطيني. لكن الحركة الوطنية الفلسطينية بعد ذلك، لا سيما بعد حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، لأسباب ذاتية وموضوعية، أو بسبب نزعة داخلية وضغوط خارجية، انزاحت عن الرواية المؤسسة وذهبت نحو الحل المرحلي، الذي يركز على دحر الاحتلال من الضفة وغزة أولاً، مع حق العودة للاجئين، وذلك في الدورة الـ 12 للمجلس الوطني الفلسطيني (1974)، الأمر الذي أهّلها لنيل الشرعية العربية والدولية كممثل للشعب الفلسطيني، بمعنى أن ذلك حصل ليس بسبب تغيير ما في موازين القوى، وإنما فقط للتماثل مع الشرعيتين العربية والدولية.
لكن في ما بعد تطوَّرَ هذا الموقف، أو تفاقم، نحو الانزياح تماماً عن الرواية المؤسسة الأولى نتيجة ضعف المنظمة، وضعف الإطار العربي والدولي الحاضن لها، لا سيما بعد انتهاء ظاهرة العمل الوطني الفلسطيني، بشكل الكفاح المسلح من الخارج (بعد الخروج من لبنان 1982)، وذلك بقبول حل إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة، واعتبار حق العودة حلاً للتفاوض عليه، وهو ما تم التعبير عنه في اتفاق أوسلو (1993) وإقامة السلطة الفلسطينية. المشكلة هنا أن ذلك جعل كل القضايا الأساسية حلاً للتفاوض لاحقاً، أي أن المنظمة تنازلت أو قايضت على وجودها في الحل، وبالتحول إلى سلطة، بدلاً من التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية التي أقرها المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني، وبدل التمسك بعنصري الحقيقة والعدالة لأي حل عادل، ولو نسبياً، للشعب الفلسطيني.
الثاني، يتعلق بتحول الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سلطة، إذ إن حركة "فتح" باتت سلطة بمعنى الكلمة في الضفة الغربية، وبالمثل فإن حركة "حماس" باتت سلطة في قطاع غزة، بكل معنى الكلمة، وهذا وذاك حصل قبل إنهاء الاحتلال، وتحت سلطة الاحتلال والحصار.
وبديهي، فإن تغير طابع الحركتين الرئيسيتين يعني أن العلاقة بينهما، سواء كانت تنافسية أو تعاضدية، باتت تخضع لذلك التغيير، أي من طابعهما كسلطتين، كل في إقليمه، مع موارد مالية، وأجهزة أمنية، وأدوات سيطرة، وفي هذا الواقع لا توجد سلطة تتنازل، ككرم أخلاق، لأخرى، ما يعني أن الصراع، أو التنافس بينهما، لا يتحدد بالمسألة الوطنية، ولا بمصلحة الشعب، بقدر ما يتحدد بمصالح كل منهما في الحفاظ على سلطته ومكانته.
أما الثالث، فهو ناتج من اعتمادية الحركة الوطنية الفلسطينية تاريخياً في مواردها على الداعمين الخارجيين، بدل اعتمادها على شعبها، وهذا ينطبق تماماً على الحركتين الرئيستين، "فتح" و"حماس" أي السلطتين، وينجم عن ذلك، لا سيما في ظروف ضعف المبنى الديموقراطي للحركة الوطنية الفلسطينية، أن تلك الحركات (أو أي من السلطتين) لا تستمد شرعيتها من شعبها، أو لا تشعر بأنها معنية بتقديم كشف حساب لشعبها، بل إنها هي التي تُعتبر بمثابة مشغّل لكتل كبيرة من هذا الشعب، ما يفسر واقع أنها لم تكن يوماً معنية بمراجعة طريقها، ونقد أوضاعها.
يا للأسف، هذا هو حال الحركة الوطنية الفلسطينية بعد ما يقارب 58 عاماً على قيامها.
*نقلاً عن "النهار"