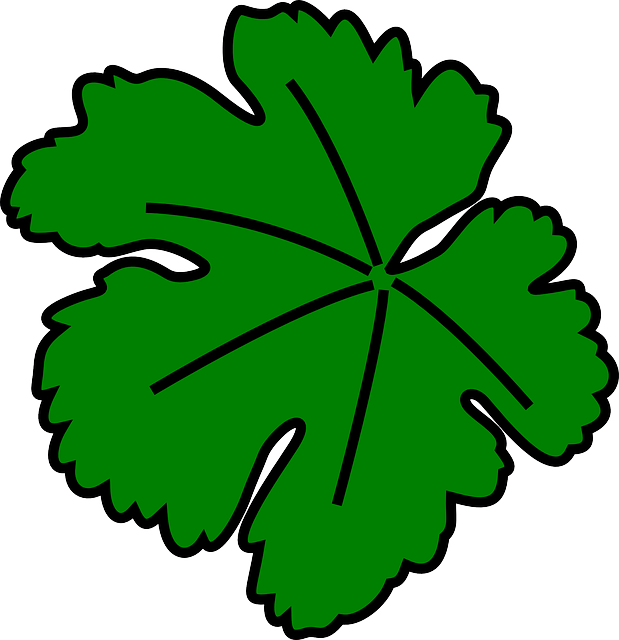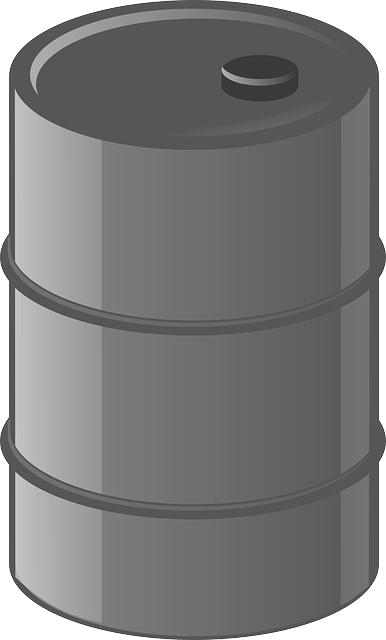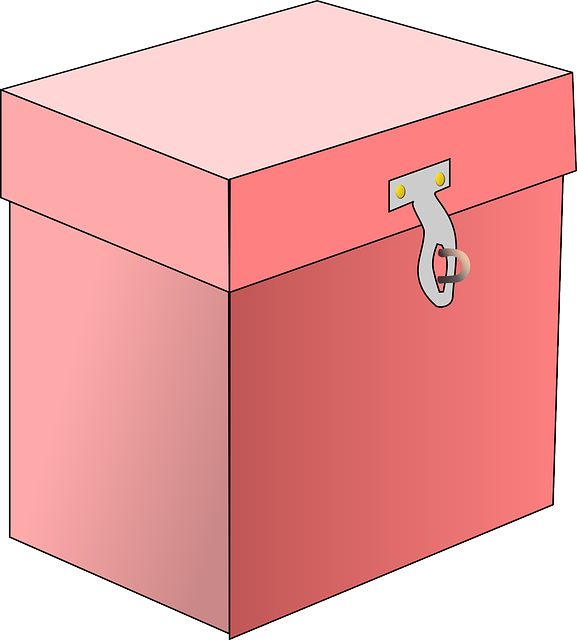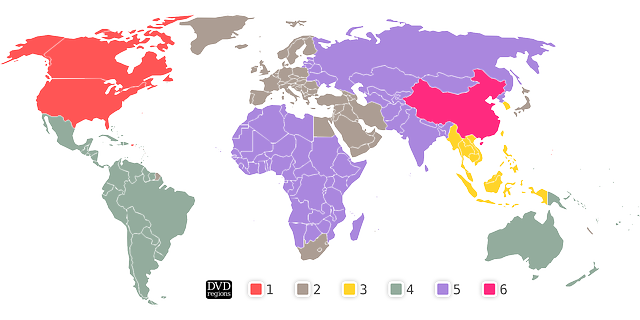من حق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يشعر بالاعتزاز في الأيام الأخيرة من العام 2022، فزيارة الدولة المطوّلة التي قام بها إلى الولايات المتحدة بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، جاءت لتضعه في مرتبة خاصة، إذ إنها الأولى التي تجري في عهد الرئيس جو بايدن الذي استنفد كامل مروحة التكريمات البروتوكولية لإبراز العلاقة القوية التي تربطه بضيفه الفرنسي شخصياً من جهة، والتقدير الأميركي غير المتناهي للدور الفرنسي بشكل عام وتعلق بلاده بالصداقة الأميركية - الفرنسية من جهة أخرى. ثم إن ماكرون يتميز عن كل من سبقه إلى قصر الإليزيه بأنه الوحيد، طيلة ستين سنة الذي حظي بزيارتَي دولة إلى واشنطن. وما كان لهذا أن يتحقق لولا نجاحه خلال الربيع الماضي، في التربّع على عرش السلطة لولاية جديدة من خمس سنوات، وقد حقق بذلك إنجازاً لم يُتَح لسابقيه فرنسوا هولاند ونيكولا ساركوزي. بل رغم خسار ماكرون الغالبية المطلقة في البرلمان المنتخب بشهر يونيو (حزيران)، فإنه أحسن الاختيار بتسمية إليزابيت بورن رئيسة للحكومة. فهذه الأخيرة نجحت في إثبات حضورها واللعب على حبل التناقضات بين المعارضات المتناحرة يميناً ويساراً، معتدلة ومتطرفة. وعندما تُسد بوجهها السبل وتجد صعوبة في جمع غالبية ظرفية لتمرير مشاريع القوانين في البرلمان، فإن ماكرون دأب على تمكينها من اللجوء إلى الفقرة 39 من الدستور التي تتيح لها طرح الثقة بحكومتها وربط مصيرها بمصير مشروع القانون المطروح على التصويت. ولأن الرئيس كان قد لوح سلفاً للمعارضة باستخدام «سلاح الردع»، أي حل المجلس النيابي... في حال سقوط الحكومة، ولأن لا أحد اليوم يريد الرجوع إلى صناديق الاقتراع، فإن النتيجة الماثلة أمام الجميع هي أن الحكومة ما زالت واقفة على قدميها، وتتأهب لطرح مشروع قانون تعديل سن التقاعد في العاشر من الشهر المقبل. ويبدو شبه مؤكد أنها ستلجأ مجدداً إلى سوط الفقرة 39 لتمريره.
يستطيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حقاً، الدفاع بثقة عن محصلة إدارته لشؤون بلاده وأن يقارن وضعها بوضع شركاتها في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها ألمانيا أو مع جارتها بريطانيا. ففرنسا لا تعرف -حتى الآن- حراكاً اجتماعياً اعتراضياً يُعتدُّ به رغم ارتفاع كلفة الكهرباء والغاز والخدمات والتضخم وانهيار القدرة الشرائية للشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
في المقابل، تعيش بريطانيا إرباكات سياسية وتواجه نزعات انفصالية -كما في حالة اسكوتلندا- وتراجعاً اقتصادياً وإضرابات واحتجاجات شعبية وتمرداً على مستوى الكومنولث. وبعكس فرنسا، فإن منتخبها الكروي أُخرج من سباق المونديال باكراً رغم أدائه الجيد ما ضاعف من خيبة لاعبيه ومناصريه والشعب البريطاني بأسره. وهذا بينما كان الشعور في باريس، رغم خسارة المنتخب الفرنسي المباراة النهائية بوجه الأرجنتين يوم الأحد 18 ديسمبر في الدوحة، يغلب عليه الامتنان لما فعله نجمه كيليان مبابي ورفاقه. ولم يتردد الرئيس ماكرون في السفر إلى قطر مرتين خلال أسبوع واحد... لا بل إنه نزل إلى أرض الملعب لتقديم الشكر للفريق على إنجازاته.
- جانب أقل إشراقاً
بيد أن كل هذه العناصر لا ترسم سوى الجزء الإيجابي من المشهد الفرنسي السياسي الداخلي. إذ إن جزأه الثاني يبدو أقل إشراقاً حيث يختلف «ماكرون 2» يختلف عن «ماكرون 1».
الأول كان الحاكم بأمره. حزبه «الجمهورية إلى الأمام» كان مطواعاً كالخاتم في إصبعه، وشركاؤه في الحكم ما كانوا يردّون له طلباً. أما الآن، ولأنه لم يعُد قادراً على الترشح لولاية ثالثة، فإن معركة خلافته قد فُتحت وهناك عدد من الطامحين.
لذا، يجد الرئيس نفسه مضطراً للنزول من عليائه الرئاسية والمساومة وتدوير الزوايا، مع تجنب استفزاز الشارع كي لا تتكرّر تجربة احتجاجات «السترات الصفراء» التي هزّت أركان ولايته الأولى في العامين 2019 و2020.
أيضاً تتوجب الإشارة إلى أن ديون فرنسا العامة وصلت إلى مستويات قياسية لم تعرفها سابقاً. ففي الفصل الأول من العام المقبل، ستكون قد تخطت سقف الـ3000 مليار يورو، وهو الأعلى في تاريخها بحيث تصل المديونية إلى نسبة 113.7% من الناتج المحلي الخام. ومع هذا العبء الكبير ستزداد كلفة خدمة الديون السنوية -أي الفوائد- على خمسين مليار يورو، وذلك لسببين رئيسيين هما:
الأول، بطبيعة الحال، ارتفاع أرقام المديونية ما يعني آلياً ارتفاع قيمة الفوائد.
والثاني، أن معدل فائدة الديون قد ارتفع عالمياً بسبب التضخم. وخلال سنة واحدة فقط استدانت فرنسا 115 مليار يورو إضافي. ولا تفيد المؤشرات المتوافرة عن تحسن في وضع المديونية الفرنسية بناءً على ما تضمنته ميزانية العام 2023. وعليه لم تتوانَ الهيئات الرقابية في الداخل والخارج عن انتقاد السياسات التي تسير عليها الحكومة. بيد أن الأخيرة تفسّر ارتفاع قيمة وخدمة الديون بالسياسة التي انتهجها الرئيس ماكرون لمواجهة تبعات «كوفيد - 19» وبالتدابير المالية التي اتُّخذت خلال الأشهر الأخيرة للحد من عبء المحروقات على المستهلكين والمساعدات المالية التي قُدمت للشرائح الأكثر هشاشة لمواجهة موجة الغلاء والتضخم. وهو تضخم لم تعرف فرنسا مثيلاً له، كما البلدان المتقدمة الأخرى منذ أربعين سنة.
- الملف الأوكراني: خيبة من بوتين
من جهة ثانية، ثمة من يزعم أن ماكرون يعوّض عن تراخي قبضته في الداخل بالإكثار من الحراك الخارجي. وما يمكّنه من ذلك أن الدستور الفرنسي يضع بين يديه السياستين الخارجية والدفاعية. فهو الذي يرسمهما ويقودهما ويشرف عليهما والوزراء ينفذون. وثمة من يرى من الدستوريين أن رئيس الجمهورية الفرنسية يتمتع بسلطات تضاهي سلطات الملك لويس الرابع عشر. من هنا، ومع نهاية العام 2022، يصح التساؤل حول محصلة دبلوماسية ماكرون للعام المنقضي في ملفات رئيسية كالملف الأوكراني والعلاقة مع نظيره بوتين أو سياسة فرنسا الأفريقية والملف اللبناني والملف النووي الإيراني والجفاء بين باريس وبرلين. والحقيقة أنه بين كل الملفات المشار إليها، استحوذ الملف الأوكراني على القسط الأكبر من اهتمامات دبلوماسية ماكرون، وذلك منذ ما قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. فالرئيس الفرنسي زار نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في الثامن من الشهر نفسه واستحصل منه على وعود أحدها إعادة القوات الروسية إلى مواقعها حالما تنتهي مناوراتها العسكرية أكانت مع القوات البيلاروسية أو قرب المشتركة الروسية - الأوكرانية. كذلك، زار العاصمة الأوكرانية كييف مرتين آملاً في الاستفادة من «العلاقة الخاصة» التي كان يعتقد أنه نسجها مع بوتين خلال ولايته الأولى. فقد كان ماكرون قد دعا بوتين إلى فرنسا مرتين، وإحداهما ذات معنى خاص، إذ كانت وجهتها صيف العام 2019 «حصن بريغونسون» المنتجع الرئاسي المطل على مياه المتوسط. كما أنه دافع دوما عن «انتماء روسيا إلى أوروبا» وعن الحاجة إلى «ربطها بالعربة الأوروبية» كي لا تلحق بالصين... وتشكل معها قوة توازن بوجه الغرب.
وخلال الأسابيع والأشهر التي تلت انطلاقة الحرب، بقي ماكرون على تواصل مع الرئيس الروسي رغم الانتقادات التي وُجهت إليه، خصوصاً من دول بحر البلطيق وبولندا وغيرها من دول شرق أوروبا، لما عدّته «تساهلاً» مع بوتين. وبالتوازي، كان ماكرون على تواصل شبه دائم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وغالباً ما أكد أن الأخير هو من يدعوه لاستمرار الاتصال ببوتين. إلا أن تصريحات سابقة لماكرون مثل «لا يجوز إذلال الرئيس الروسي»، أو أخيراً عندما لفت إلى الحاجة لـ«تقديم ضمانات أمنية لروسيا»، هشّمت صورته إلى حد بعيد، علماً بأن باريس، منذ شهر مارس (آذار) الماضي أصبحت من أشد المنددين بموسكو. وبعدما كانت تتردد في تسليم القوات الأوكرانية أسلحة، تغير موقف باريس من النقيض إلى النقيض. ويوم 13 الجاري، استضافت العاصمة الفرنسية مؤتمرين، أحدهما دولي والآخر ثنائي فرنسي - أوكراني افتتحهما ماكرون وزيلينسكي معاً، وكان هدف الأول توفير الدعم للاستجابة للحاجات الأوكرانية الطارئة (كهرباء، ومياه، وصحة، ونقل، وأمن غذائي، وبنى تحتية) لتمكين أوكرانيا من تمضية فصل الشتاء بعد تركيز الروس على قصف منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية. ونجحت فرنسا بالفعل في توفير ما يزيد على مليار يورو لهذه الأغراض. وعدّت مبادرة باريس مسعى لإبراز وقوفها إلى جانب كييف بينما لم يتردد زيلينسكي بوصف ماكرون بـ«العزيز إيمانويل» مقابل «العزيز فولوديمير».
من جانب لآخر، منذ أكثر من شهر، يؤكد ماكرون أنه سيتصل ببوتين ولكن هذه المرة لدعوته لوقف مهاجمة المنشآت المدنية الأوكرانية التي وصفها بأنها «جريمة حرب» ومن أجل سحب الأسلحة مختلفة الأنواع من محيط محطة زابوروجيا النووية. لكن الاتصال لم يحصل. وحتى الساعة، ليس هناك تاريخ محدد للتواصل بين الرئيسين. ووفق مصادر أوروبية في باريس، فإن ثمة «تمنعاً» روسياً بقبول التواصل مجدداً مع ماكرون، لسبيين اثنين:
الأول، أن الكرملين يرى أن فرنسا لم تعد مؤهلة للعب دور الوسيط «لأن مواقفها لم تعد مختلفة عن المواقف الأميركية والأطلسية» بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنها تنشط لشد الخناق الدبلوماسي والاقتصادي على موسكو.
والآخر، أن موسكو لم تتردّد في التعبير عن حنقها من بث القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي برنامجاً وثائقياً ليل 30 يونيو الماضي تضمّن تسجيلاً مصوّراً لمكالمة هاتفية من تسع دقائق حصلت يوم 20 فبراير الماضي، بين ماكرون وبوتين. وعلق لافروف في 6 يوليو (تموز) على هذا بقوله: «إن الأعراف الدبلوماسية لا تتقبل تسريبات أحادية الجانب لتسجيلات كهذه». وفي المحصلة، لا يمكن القول إن دبلوماسية ماكرون قد أصابت نجاحاً في ملف رئيسيّ كالحرب في أوكرانيا رغم الجهود التي بذلها بل إن بعض مبادراته شوشت صورته لدى الطرفين الروسي والغربي.
- الطلاق مع ألمانيا
على المستوى الأوروبي أيضاً، من نافل القول التذكير بأن ألمانيا وفرنسا تُعدّان، تاريخياً، «القاطرة» التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى الأمام. ومنذ ستة عقود، عمل قادة البلدين يداً بيد، مثل الجنرال شارل ديغول وكونراد أديناور، وفاليري جيسكار ديستان وهيلموت شميت، أو فرنسوا ميتران وهيلموت كول... بل حتى ماكرون وأنجيلا ميركل. وعندما تصاب هذه العلاقة بالاهتزاز تتوقف المسيرة الأوروبية.
لكن منذ مجيء أولاف شولتس إلى المستشارية في برلين قبل سنة تماماً، غابت الحرارة عن العلاقة بينه وبين ماكرون، ولم يكن الجانب الشخصي المسؤول الأوحد. فلقد بينت أشهر العام 2022 عن اختلاف الرؤى بين الجانبين الأمر الذي برز بقوة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما أجل الاجتماع السنوي الرئيسي بين حكومتي البلدين الذي كان مفترضاً انعقاده برئاسة ماكرون وشولتس في ذلك الشهر في قصر فونتينبلو التاريخي الواقع جنوب باريس.
الطرفان سعيا لإخفاء الأسباب الحقيقية التي حالت دون التئامه، ولكن دون جدوى. وبرزت في الأفق ثلاثة ملفات خلافية، اعتبرت باريس أن برلين تخلت فيها عن التضامن معها مفضلةً عليها خيارات أخرى. ويأتي في مقدمها ملف بناء درع دفاع جوي أوروبي الذي قادته ألمانيا بمشاركة 14 دولة أوروبية ولكن من دون فرنسا. وما أزعج باريس أن قرار برلين، التي قرّرت تخصيص 100 مليار يورو لتعزيز قواتها المسلحة، جاء لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل بينما بقيت الصناعات الدفاعية الأوروبية على الهامش... مع أن فرنسا وإيطاليا تعملان على بناء دفاعات صاروخية.
ويضاف إلى ما سبق أن برلين وباريس تختلفان بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي على غرار ما حصل بالنسبة للنفط. وبينما باريس تدفع بالشروع إلى الأمام، تعارض برلين ذلك -مدعومة من الدنمارك وهولندا- مخافة أن تتوجه شحنات الغاز إلى الأسواق التي توفر العائد الأعلى. أيضاً، فإن الجانبين يتناقضان في رؤية خطة برلين دعم صناعاتها، إذ ترى فيها باريس ضرباً للمنافسة الشريفة. ويضاف إلى كل ذلك أن مجموعة من المشاريع الصناعية الدفاعية المشتركة (طائرة قتالية مشتركة، دبابة المستقبل...) لم تحقق اختراقات ذات معنى، بل استدارت ألمانيا نحو الولايات المتحدة لتجديد قوتها الجوية بتوقيع عقد لشراء طائرة «إف 35» متجاهلةً طائرة «رافال» الفرنسية القتالية. وهكذا، ترى فرنسا أن خيارات ألمانيا تعني نسف الطموحات الأوروبية لبناء صناعات دفاعية مشتركة ومنافسة، وتضعف الدعوة لاستقلالية دفاعية واستراتيجية أوروبية.
الثابت حتماً أن الحرب الروسية واقتراب الخطر يدفعان ألمانيا لمزيد من التقارب مع واشنطن على حساب علاقاتها الأوروبية. بيد أن الجانبين الفرنسي والألماني سعيا في الأسابيع الأخيرة إلى قلب صفحة الخلافات فتكاثرت الزيارات الوزارية المتبادلة في الاتجاهين، وزار شولتس باريس للتعويض عن الاجتماع المشترك المؤجل ما خفّض حرارة التوتر. وكان لافتاً أن ماكرون كلف شولتس تمثيله في «قمة الاتحاد الأوروبي - منظمة دول جنوب شرقي آسيا»، ما يدل على الرغبة في التقارب مجدداً بانتظار الاجتماع الحكومي الموسع الشهر المقبل بمناسبة الذكرى الستين للتوقيع على «معاهدة الإليزيه» التي كرست المصالحة بينهما.
- إيران: الدبلوماسية الخاسرة
> يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي وبعد أربعة أيام على «وفاة» الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لمناقشة مصير الاتفاق النووي الذي وصلت المفاوضات بشأنه بين طهران والغربيين بوساطة أوروبية إلى طريق مسدود.
الاجتماع كان الأول وجهاً لوجه، لكن ماكرون سبق أن تواصل مع رئيسي غير مرة، وكان الرئيس الغربي الوحيد الذي بقي ثابتاً في التواصل بشكل منهجي مع السلطات الإيرانية مهما كان لونها السياسي. وتجدر الإشارة إلى أنه سعى عام 2019 لوساطة بين طهران وواشنطن لا بل إنه دفع للتواصل ولكن دون نتيجة بين الرئيسين دونالد ترمب وحسن روحاني.
أيضاً كان ماكرون من أشد المدافعين عن الاتفاق النووي، وحاول إيجاد آلية للالتفاف على العقوبات الأميركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب لإقناع روحاني بالبقاء داخل الاتفاق. لكن الجهود الفرنسية ومعها الأوروبية ممثلة في «وزير» خارجية الاتحاد جوزيب بوريل لم تؤتِ ثمارها، لا بل إن العلاقات بين باريس وطهران بالغة السوء في الوقت الحاضر، لجملة أسباب منها أن باريس، كما العواصم الغربية، تحمّل طهران مسؤولية فشل المفاوضات، ولم تعد باريس تتردد في التنديد بإيران لا بل تهديدها بنقل الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي ما يعني آلياً إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بموجب آلية «سناب باك» التي لا تحتاج لقرار جديد من مجلس الأمن. وبالتوازي، فإن باريس قلقة من تطور البرنامج النووي الإيراني ومما يشكله من خطر على الإقليم.
ومن الأسباب أيضاً أن إيران تسجن سبعة مواطنين فرنسيين تسوق بحقهم تهماً مختلفة ليس أقلها التجسس والسعي لإطاحة النظام... بينما ترى باريس أن هؤلاء الأشخاص «رهائن دولة» يريدهم الجانب الإيراني للضغط عليها وربما لاستخدامهم أوراقاً للمساومة من أجل استرجاع مواطنين إيرانيين في السجون الأوروبية وتحديداً في بروكسل. وغير مرة، دعت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، طهران للإفراج «الفوري» عن السبعة ولكن دون طائل.
- فرنسا... و«الصفعة الأفريقية»
> منذ العام 2014 ترابط قوة فرنسية وصل عديدها إلى أكثر من خمسة آلاف رجل في دول الساحل الأفريقي خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وهذه القوة -اسمها «برخان»- جاءت امتداداً لقوة أخرى أرسلتها فرنسا بشكل طارئ إلى مالي لمنع سقوطها بأيدي التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها «داعش - الصحراء الكبرى» و«القاعدة» (نصرة الإسلام والمسلمين). وبعد ثماني سنوات من التمركز في مالي، اضطر المسؤولون الفرنسيون إلى إنهاء وجودها في هذا البلد الذي عرف انقلابين عسكريين عامي 2020 و2021، وعمد «المجلس العسكري» الذي سيطر على السلطة هناك إلى التقارب مع ميليشيا «فاغنر» الروسية رغم التحذيرات التي وجهتها باريس، علماً بأن الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا فرضا عقوبات اقتصادية وعزلة دبلوماسية على الطغمة العسكرية.
ولم تخرج «برخان» وحدها من مالي، إذ سبقتها في الخروج قوة الكوماندوس الأوروبية «تاكوبا» التي جهدت باريس لتشكيلها من سبع دول أوروبية. وبالتوازي، أخذت عدة دول مشاركة في القوة في إعلان انسحابها من قوة السلام الدولية في مالي «مينوسما» عقب القرار الفرنسي، آخرها ساحل العاج، وذلك بعد السويد وبريطانيا ومصر، وتتأهب ألمانيا لاتخاذ قرار مماثل.
حقيقة الأمر أن باريس مُنيت بلطمة في مالي وهي بصدد إعادة انتشار قواتها وتريد تغيير استراتيجيتها التي ثبت إخفاقها بالتركيز على دول خليج غينيا التي تتخوف من نزول المتطرفين من الشمال باتجاه أراضيها. فضلاً عن ذلك، مُنيت الدبلوماسية الفرنسية بنكستين إضافيتين في مستعمرتيها السابقتين الأخريين تشاد وبوركينا فاسو. في تشاد، لم تفتح وفاة الرئيس إدريس ديبي، الباب لانتقال دستوري للسلطة، بل تولى ابنه الشاب الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة، وعمد إلى حل البرلمان وترحيل الحكومة، وأسس سلطة جديدة وضعت فرنسا في موقف صعب. فباريس ما فتئت تدعو إلى تعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة. وفي بوركينا فاسو وقع انقلاب عسكري آخر في سلسلة خضّاتها السياسية.
فضلاً عن ذلك، تشكو فرنسا من منافسات متعددة لنفوذها في أفريقيا من كل من الصين وتركيا والولايات المتحدة، وخصوصاً روسيا عبر «فاغنر». وبيّنت واشنطن، من خلال «القمة الأميركية - الأفريقية» في واشنطن أنها تملك القوة الضاربة وأنها عائدة للاهتمام بأفريقيا فيما النفوذ الفرنسي آخذ بالضمور.
... والبحث المستمر عن دور في لبنان
> ليس سراً بالنسبة لأحد أن إيمانويل ماكرون يريد أن يكون له دور في لبنان. ولا حاجة للتذكير بالزيارتين اللتين قام بهما في أغسطس (آب) وسبتمبر من العام 2020 عقب انفجاري المرفأ وطرحه «خطة إنقاذ» مالية، اقتصادية وحتى سياسية.
كذلك، تجدر الإشارة إلى الوعود التي أغدقها، ومنها الدعوة لمؤتمر دولي جديد من أجل إنقاذ لبنان إذا نفّذت الخطة الإصلاحية. هذا فضلاً عن اجتماعات «مجموعة الدعم للبنان» التي التأمت مراراً من أجله والاتصالات التي قام بها مع قادة كبار من المنطقة، وطرحه الملف اللبناني في كل محفل حل به بما في ذلك إبان زيارته لواشنطن واجتماعه بالرئيس جو بايدن وفي اجتماع «قمة بغداد 2» في الأردن. وأيضاً كان لماكرون دور في التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
لكنَّ همَّ فرنسا اليوم -وهي التي نبّهت منذ الصيف الماضي إلى الشغور الرئاسي- أن تدفع سريعاً باتجاه تقصير زمنه لما له من انعكاسات على كل الأوضاع اللبنانية. والحال أن تجربة ماكرون اللبنانية مُرّة الطعم، والطبقة السياسية اللبنانية بمختلف تشكيلاتها خيّبت أمله. والمشكلة الأساسية التي عانى منها أن وعوده لم تكن كافية لإغوائها، وهراوة العقوبات التي رفعها بوجهها كانت غير رادعة. واليوم تريد باريس رئيساً جديداً للجمهورية وهي خائفة على مصير لبنان. بيد أن العقدة الأساسية موجودة في طهران عبر «حزب الله» وشروطه وإصراره على التمسك باختيار رئيس جديد يتماشى مع خياراته. ورغم التواصل المستمر، عبر قنوات عدة، بين باريس و«حزب الله»، تبدو قدرة التأثير الفرنسية عليه، عبر طهران، محدودة بسبب تراجع العلاقات بينها وبين باريس.