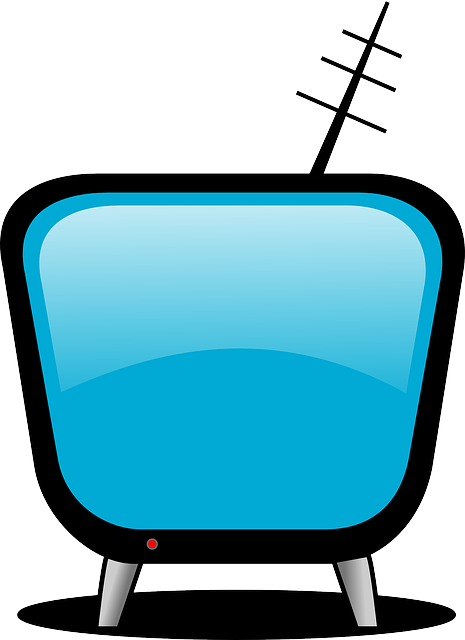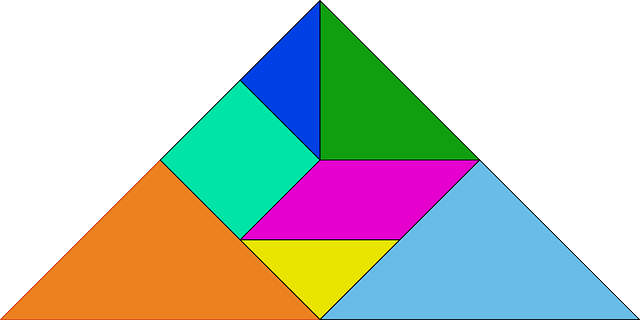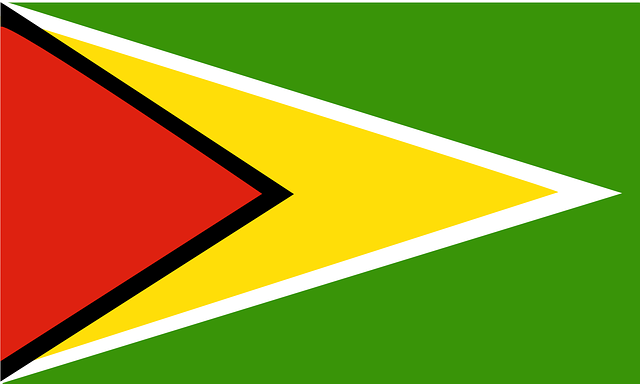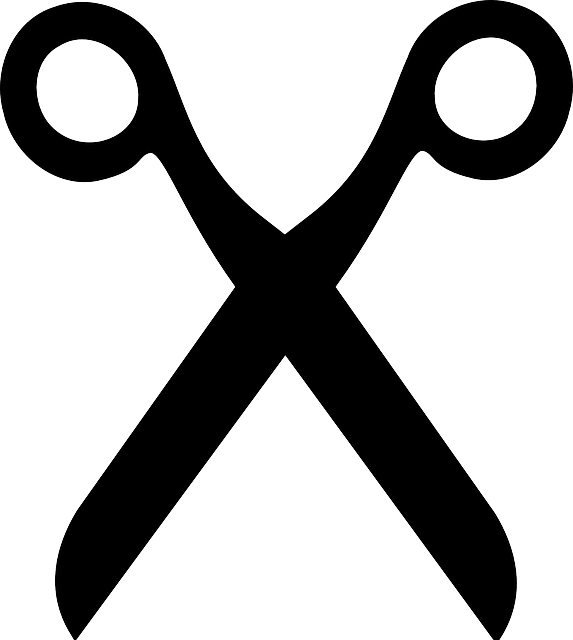عندما أطلق “كارل ماركس” قولته الشهيرة “الدين أفيون الشعوب” أو “الدين أفيون الجماهير” كما في ترجمات أخرى عن العبارة الأصلية باللغة الألمانية Die Religion … ist das Opium des Volkes” التي حاول أن يختزل من خلالها، من وجهة نظره، دور الدين في المساهمة القوية في خنوع الفئات الإجتماعية المسحوقة، وعدم تحركها ومجابهتها للظلم واستبداد الدولة الدينية.. فهو لم يقصد فقط فعل الدين نفسه في أفراد المجتمع، “كوسيلة تدميرية ذاتية”، من حيث استفراد المعتقد الغيبي بالذات البشرية، وتحييدها عما يمكن أن يكون سببا في أي تطور أو تقدم. بل أكد أيضا -وهو ما نجده مدبجا بوضوح على طول فقرات مقدمة كتابه “في نقد فلسفة الحق عند هيغل”- أن الدين يستخدم حصريا من طرف الدولة الحاكمة المستبدة لتخفيف الآلام وتهدئة الشعوب، وكبح ثوراتها ومطالبها في التغيير.
إن “كارل ماركس” تناول المسألة الدينية باعتبارها الوسيلة المعتمدة من طرف الدولة الحاكمة المستبدة القاهرة لشعبها، في حيز زمني ومكاني محدد، لبسط سيطرتها السياسية وتسخير الكنيسة إذاك كمرشد فكري وأيديولوجي لديمومة الاستغلال الطبقي، ووضع الشعوب بموضع المتلقي الخاضع بشكل سلبي، وليس باعتبارها المحرك الأساسي للتغيير.
لست هنا بصدد مناقشة أفكار “كارل ماركس” حول الدين، ولست مؤهلا للدفاع لا عن الدين، ولا لمناكفة ودحض ما يعتقد هذا الفيلسوف الكبير أنه صحيحا. لكن! أعترف أني معجب بشكل كبير بعمق الفكرة، من حيث كونها تجسد واقعا عابرا للزمان، وغير مرتبط إلى الأبد ببيئة أو مكان محدد. وعمق ما تقدم به “كارل ماركس” هنا هو فضح المحاولات الدائمة عبر التاريخ لقوى الاستبداد بشغل الناس عن همومهم الاستراتيجية، بأمور تجد لها صدى في خواطرهم، وتكون حاجزا بينهم وبين تحقيق الازدهار الجماعي، في نفس الوقت الذي تخدم فيه بشكل قوي مصالح الحكم المستبد، وليس الدين هنا هو القادر فقط على لعب هذا الدور في كل العصور.
إن تعميم الحديث عن أن الدين أفيون للشعوب بدون تحديد أي دين هو المقصود، وبدون الـتأكيد على الاختلاف الجوهري بين السياقات التاريخية، والبنيات الذهنية، والمقومات الحضارية للبيئة التي نشأ فيها رواد هذا الطرح الفلسفي، وبين نظيره في بلدان الشرق الإسلامي ومغاربه، وبدون التأكيد على أن عمق الفكرة أوسع من أن يتم الحجز عليها في قفص فاعل واحد، هو نفس التعميم المخل الذي يمكن أن يحصل إن تمت المقارنة في هذا العصر بين ممارسة كرة القدم، وسياسة كرة القدم، وعشق كرة القدم في الدول المتقدمة، وتعلق شعوب هذه الدول بها، وبين الممارسة والسياسة والعشق لنفس الرياضة عند مجتمعات الجنوب المتخلف، فهؤلاء كرة القدم عندهم مختلطة بالعقد الاجتماعية والأزمات الاقتصادية والسياسات العمومية المنخورة بالفساد المطلق، ومؤشرات في الحضيض للتنمية البشرية. وأولئك يميزون بشكل واضح بين ما هو أساسي ضروري، وبين ما يعتبر كمالي جزئي يهم الحياة الموازية المجتمعية، وحكومات تسعى راغبة وراهبة لإرضاء شعوب تعي جيدا ما معنى الفصل بين السلط، وأهمية وجود أنظمة قانونية متطورة يلتزم الجميع بتطبيقها، ومؤسسات موازية للمتابعة والمحاسبة، وحقوق وواجبات المواطنة مسألة حجزت لها مكان عميقا في الوعي الجماعي لهذه الشعوب.
فالدين شأنه في ذلك شأن جميع المجالات الأخرى التي تهم المواطن أو يتهمم بها في حياته اليومية، قد تم الاستيلاء عليه من طرف الدولة المستبدة، واستخدمته بمكر وفجاجة، من خلال لي أعناق نصوصه لخدمة مصالحها. فإذا كان الدين في عصر “كارل ماركس” والعصور التي سبقته في أوروبا، قد لعب بشكل خطير ومتميز هذا الدور، من خلال ما كانت تقوم به الكنيسة، وتغلغلها في مفاصل المجتمع تأثيرا بدون تأثر، فإنه في عصرنا هذا وفي مكان آخر غير أوروبا، قد تنازل عن جزء من أدواره، لصالح فاعلين آخرين، أشد تأثيرا في المجتمعات المتخلفة، ولعل أخطرها الرياضة الأكثر شعبية في وقتنا الحاضر كرة القدم.
قبل عصر الأنوار في أوروبا عرفت هذه القارة ما يسمى تاريخيا بعصر النهضة، لكن ما سبق هاتين الفترتين التاريخيتين، وباتفاق جميع المؤرخين، كان تاريخا طويلا من الظلام والهمجية والتوحش، لعبت فيه الكنيسة دورا محوريا في استمراره وتدثره بدثار الدين من خلال ممارسات أخذت من الوثنية اليونانية القسط الأكبر، ولسنا هنا بصدد التفصيل في هذا الموضوع، لكن فقط للتأكيد على أن مفكري التنوير كانت لهم دوافع قوية لاعتبار الدين -وهم يقصدون أساسا الدين الكنسي- مصدرا للتخلف الطويل الأمد، في وقت كان الإسلام في بعض الفترات التاريخية الموازية، يعرف ازدهارا -أو مساهما على الأقل- في مختلف المجالات الفكرية والمعرفية والعلمية، ولم يكن للمسجد نفس الدور السلبي الذي كان للكنيسة.
إذن فأي مقارنة بين سياقات ديانتين مختلفتين على مستوى الأداء الحضاري، هي مقارنة مجحفة، وأي محاولة لإسقاطات غير مرتبة زمنيا وجغرافيا، هي محاولة ركيكة في تمفصلاتها التاريخية الاجتماعية.
وهي الركاكة ذاتها التي يمكن نعتها بأي محاولة للربط بين الممارسة الكروية بأوروبا مثلا، ونظيرتها بالدول المتخلفة.
الدين كان أفيونا للشعب الأوروبي، استغلته الدولة لممارسة استبدادها في القرون الوسطى، وكان يعني الجمال والفكر والتقدم في العالم الإسلامي في نفس الفترة التاريخية أو بالموازاة معها، “الأندلس مثلا”.
كرة القدم هي الآن، كما يراد لها، أفيون الشعوب المتخلفة، تستغلها الدول لإدامة استبدادها وشرعنة وجودها، وهي تعني الجمال والرياضة والطاقة وجودة الحياة، في الدول المتقدمة بدون أن تكون حاجزا أمام أي فعل سياسي إيجابي.
فكيفما كانت الوسيلة المستخدمة من طرف الدولة الحاكمة المستبدة لتنويم وإلهاء شعوبها عن الاهتمام بالشأن العام، وإبداء رأيها في السياسات العمومية، ومتابعاتها الذكية لأوجه صرف الثروات المشتركة، هي أفيون لهذه الشعوب، ولكل عصر أفيونه ومخدره. فالمشكل ليس في الوسيلة المستعملة بل في الهدف من استخدام الدولة لها، فسواء تعلق الأمر بدين من الديانات، أو معتقد من المعتقدات، أو مذهب من المذاهب، أو لعبة شعبية جامحة، فالأمر سيان إذا تعلق الأمر بتوجيه الدولة لها لخدمة أجنداتها.
كرة القدم -كما تريدها الأنظمة المستبدة والمؤسسات المتسلطة- هي أفيون هذا العصر، وأي أفيون؟ وإلا فما معنى أن تصل لعبة إلى هذه الدرجة من الاهتمام الرسمي وعلى أعلى مستوى بها؟ وأي تفسير يمكن أن نجده لكل هذه الأموال الطائلة التي تصرف على المنتخبات الوطنية، وبسخاء يعز أن نجد له نظيرا في المجالات الحيوية التي تهم المواطن بالدرجة الأساس، كالتعليم والصحة والتشغيل الخ.. هذه المجالات الثلاث والتي تعتبر أعمدة التنمية السوسيواقتصادية لكل بلد، قد لا نفاجأ بتوحد الدول المتخلفة، وتضامنها في احتلال المراتب المتأخرة في التصنيفات الدورية التي تصدرها الأمم المتحدة أو المؤسسات الموازية الأخرى، في الوقت الذي نجدها تتنافس وتبذل الغالي والنفيس، لاحتلال مرتبة متقدمة في منافسة قارية في رياضة كرة القدم، مع ما يصاحب هذا اللعب الجماعي من نفخ في عصبية حديثة تافهة، لاستجلاب متعة لحظية جماعية قد تنسي ولو إلى حين الانهزامات المتتالية في مجالات التنمية البشرية.
إنها سياسة الإلهاء نفسها، قد يتغير الموضوع بدون تغير السياسة المتبعة، فما دامت كرة القدم تقدم نفسها بقدرتها دون غيرها على خدمة مشروع الاستبداد فلم لا؟
لم لا تستخدم كأفيون عالي التأثير كما استخدم الدين سابقا في أوروبا العصور الوسطى؟ لم لا ندعها تحمل مشعل الإلهاء ما دامت الجماهير قد اختارتها كهوية وانتماء وعصبية، تتضاءل أمامها باقي الانتماءات والعصبيات الأخرى، بكل زخمها التاريخي، وقوة حضورها في المخيال الجماعي الذي أصبح مهددا بلعبة تافهة.