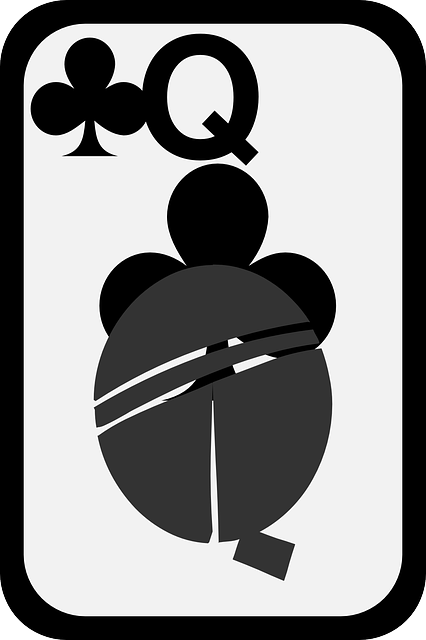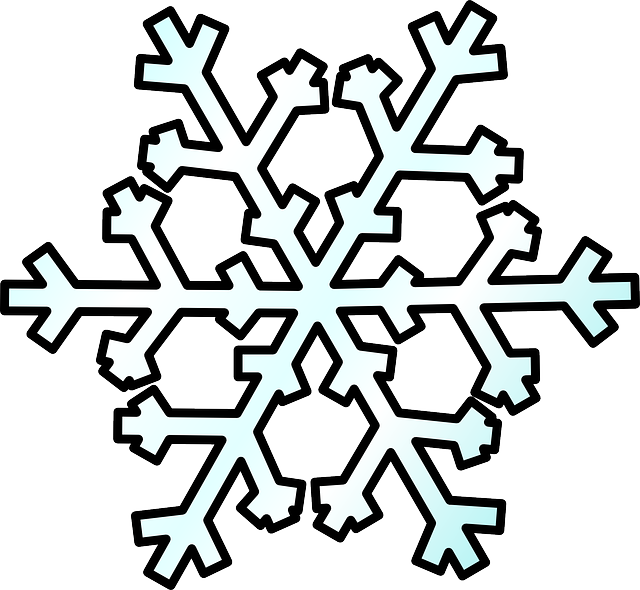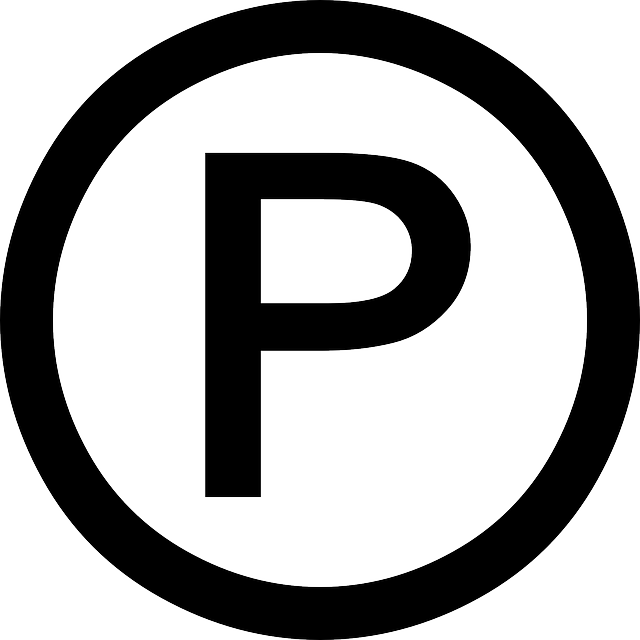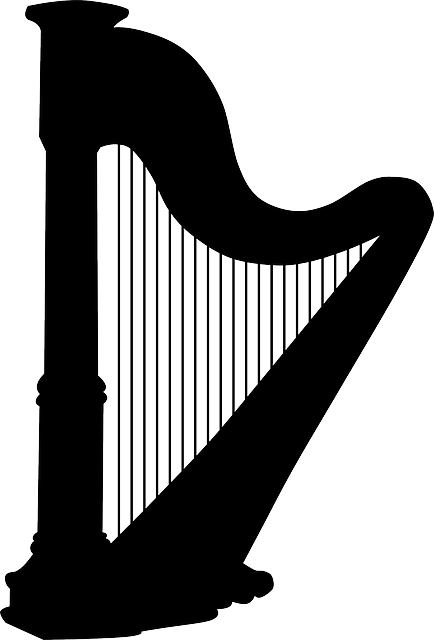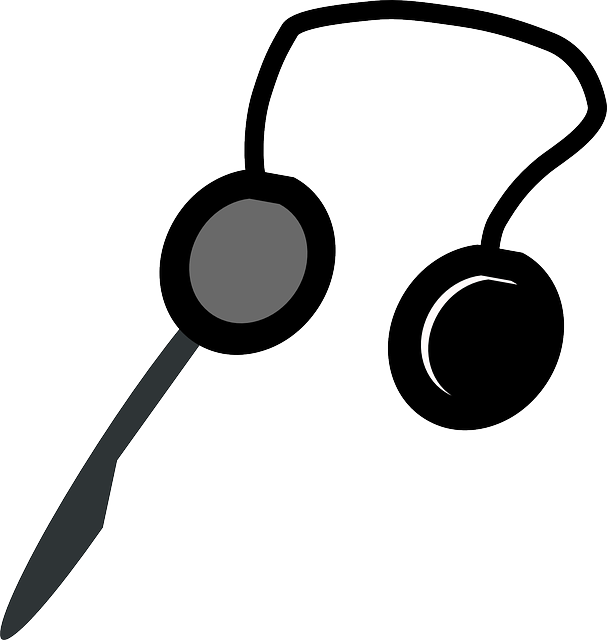الحمد لله الذي لا تراه العيون، ولا تحيط به الظنون، أشهد أن لا إله إلا هو-سبحانه- إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الدرّ المكنون والجوهر المصون، ما رأت مثله –قبله ولا بعده- العيون. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة تنفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون.
يقول ربّنا عزّ وجلّ: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [آل عمران: 159]
هذه درّة من درر القرآن، وجوهرة من الجواهر الحسان في عقد سورة آل عمران…
آية كريمة تتقاطر رحمة، وتسيل حكمة، وتفيض محبّة وعطفا، ولينا ولطفا…
وعلى رغم قصر حجمها وقلّة ألفاظها إلا أنها تحمل في طياتها حقيقتين أصيلتين عظيمتين:
الحقيقة الأولى هي حقيقة الرحمة الهائلة التي جاد بها المولى الكريم على هذه الأمة خاصة وعلى البشرية عامة.
والحقيقة الثانية هي حقيقة هذا الرجل الحليم والنبي الكريم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين.
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
قال الطنطاوي في التفسير الوسيط: “والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبئ عنه السياق من استحقاق الفارين والمخالفين للملامة والتعنيف منه. صلّى الله عليه وسلّم بمقتضى الجبلة البشرية. والباء هنا للسببية، و«ما» مزيدة للتأكيد ولتقوية معنى الرحمة.” غير أن جلّ المفسرين على أنّ “ما” صلة وهي كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا[البقرة: 26] وكقوله جلّ جلاله: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ[النساء: 155- المائدة: 13]، وعَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ[المؤمنون: 40] وقيل: “ما” استفهام. والمعنى: فبأي رحمة من الله لنت لهم؛ فهو تعجيب.
والمعنى كما قال سيدنا قتادة هو: فبرحمة من الله لنت لهم
والحقيقة هي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد حصل منهم –خطأً- يستدعي غضبه عليهم وتأنيبه لهم، بل إن ما فعلوه كان مخالفة صريحة صارخة لأمر القائد يستحقون عليها أشدّ العقوبة… لكنّه –صلى الله عليه وسلّم- عاملهم باللين والحسنى. فأي رحمة هذه التي جعلته على هذا النحو لولا رحمة الله عز وجل به وبهم…
وإنها لأخطاء جسام، وعثرات لم تكن بالحسبان… فقد تحمس القوم للخروج، ثم اضطربت صفوفهم، فتراجع ثلث الجيش قبل المعركة، وخالفت فئة من الرماة – بعد ذلك – عن أمره رغم تحذيره الشديد، وضعفوا أمام إغراء الغنيمة، ثم وهن الجميع أمام إشاعة مقتله، وانقلبوا على أعقابهم مهزومين، وأفردوه في النفر القليل، وتركوه يثخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في أخراهم، وهم لا يلوون على أحد. صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للهزيمة والحرب قائمة على ساق.
في هذه الظروف العصيبة حيث تتحطّم نفسية الإنسان، ويشعر القائد بفداحة الخذلان، وتحدّثه النفس بإنزال العقوبات الشديدة على من خالفوا الأوامر… يتوجه المولى الكريم سبحانه إلى حبيبه –عليه الصلاة والسلام-يطيب خاطره، وإلى المسلمين يشعرهم نعمةَ الله عليهم به. ويذكّره ويذكّرهم رحمة الله المتمثلة في خُلقه الكريم وقلبه الرحيم الذي تتجمع حوله القلوب… يستجيش كوامن تلك الرحمة العظيمة التي أودعها –سبحانه- في قلبه –صلى الله عليه وسلّم- لتغلب ما أثاره تصرفهم من غضب، وما أهاجه خطؤهم من انفعال وأوَب… وليحسّوا هم حقيقة النعمة الإلهية بهذا النبي الكريم.
وهكذا يكون القائد الحكيم… لا يكثر الذم واللوم، فكثرة التعنيف واللوم مجلبة لليأس عند القوم، وإنما يلتفت إلى الماضي ليأخذ منه عبرة، ثم ينظر لحاضره ومستقبله فيغرس فيه بذرة.
أما وإن الشدة في غير موضعها تفرق ولا تجمع، وتضرّ ولا تنفع.
في مواقف كهذه – والحزن يفتّت أكباد الرجال- لا حاجة لمزيد من الملح على الجرح… ضع مرهما وضمادا… وطبطب على القلوب المتألمة واسقها أملا. اشحذ العزائم، حفّز الهمم، وبشّر –اخوتك- بمستقبل أفضل. وحينها سترى الأفضل.
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
“الفظ” الجافي، و“الغليظ القلب” القاسي القلب، غير ذي رحمة ولا رأفة. ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، بل وصفه الله بعكس ذلك: بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [سورة التوبة: 128]
فنفى عنه سبحانه سيء الأخلاق وأثبت له مكارمها… نفى عنه الفظاظة وهي الجفاء والخشونة وقلّة الاحتمال، والفَظُّ: ماءُ الكَرِشِ يُشرَبُ عِنْدَ عَوَز الماءِ في المفاوز، فهو يشرب على كره بسبب الاضطرار… لذلك فالإنسان الفظ الجافي هو كماء كرش الإبل لا يطاق جانبه ولا تحتمل عشرته إلا اضطرارا… ونفى عنه -كذلك- غلظة القلب، و”غليظ القلب” هو الذي لا يتأثّر بشيء ولا يتفاعل عاطفيا مع الأحداث حوله… فلا يسعده فرح ولا يحزنه قرح… متجهمّ الوجه، قليل الانفعال في الرغائب، وقليل الإشفاق والرحمة في المصائب، ومن ذلك قول الشاعر:
يُبكى علينا ولا نبكي على أحد*** لنحن أغلظ أكبادا من الإبل
والغلظة والفظاظة من الأخلاق المنفرة التي لا صبر للنّاس على معاشرة صاحبهما حتى وإن كثرت فيه الفضائل، ورُجيت منه الفواضل…
فنفى الله تعالى عن حبيبه صلى الله عليه وسلّم ما ليس من طبعه وأثبت له ما جبله عليه من لين ورحمة ورأفة. ولقد جاء في التوراة وصفه على هذا النحو: “ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح”[رواه البخاري عن عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 4838].
فلين جانبه صلى الله عليه وسلّم، وحسن عشرته، وصدق محبّته، جعلته محبوبا سالبا للقلوب حيث ما ساقها انساقت وحيث ما أرسلها انطلقت. ولو كان فظّا غليظ القلب لانفضّ النّاس من حوله وتفرّقوا، وتركوه وشأنه وبمن هو أرأف بهم منه التحقوا، وما يبالون حينها بما فاتهم من الإقبال عليه، ولا بما ضيّعوا من عدم التحلّق حواليه.
وما أحوج أُسرنا – جميع أسرنا- في هذه الأيام التي كثرت قسوتُها وعظمت فتنتُها واحتدّت أنيابها إلى حضن دافئ رحيم، وكنف عطوف كريم، يتصدّق على الناس بابتسامته، ويجود عليهم ببشاشته، ويسخو عليهم بعطائه، ويجزل لهم من عفوه. لا يضيق بضعفهم، ولا يضجر بجهلهم. لا يكثر اللوم، ولا يسرف في الذّم… بل يعاملهم بالتي هي أحسن، لا بالتي هي أغلظ وأخشن.
ما أحوجنا إلى قلوب رحبة تجسّد فينا حقيقة الصحبة… تعطي ولا تنتظر العطاء… تحمل هموم الناس ولا تفتنهم بهمّها، تكلؤهم بالعناية، وتشملهم بالرعاية، وتكتنفهم بالاهتمام.
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
قال الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة رحمه الله تعالى: «{فاعف عنهم} فيما يختص بك، {واستغفر لهم} في حق ربك حتى يشفّعك فيهم»
وهو نفس ما أشار إليه الإمام الزمخشري -رحمه الله تعالى- في الكشاف: «{فَٱعْفُ عَنْهُمْ} فيما يختص بك {وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ} فيما يختص بحق الله إتماماً للشفقة عليهم».
والعفو تمام السماح وكمال الصفح حتى لا يبقى في القلب على من أخطأ في حقّك غيظ ولا حنق. وهي درجة عالية في الكمال الخلقي… لكن أعظم منها مرتبة ألا تعفو –أنت- فقط بل تسأل الله المغفرة لمن أساؤوا إليك…
“اللَّهمَّ اغفِرْ لقومي فإنَّهم لا يعلَمونَ“[رواه ابن حبان في صحيحه عن سهل ابن سعد –رضي الله عنه- 973]
فإن كان هذا حاله –صلى الله عليه وسلم- مع الكفار الذين أدْموا وجهه وآذوه عن سبق إصرار…كيف يكون حاله من المؤمنين الأطهار، الذين اعتراهم الانكسار تلو الانكسار… فلما رأوا أن قد أخطأوا عادوا نادمين يقدّمون الاعتذار.
و للفخر الرازي في قوله تعالى: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ نفيسة عجيبة: «إنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولا بقوله: وَلَقَدْ عَفَا الله عَنْهُمْ[آل عمران: 155] ثم أمر محمدًا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالاستغفار لهم ولأجلهم، كأنه قيل له: يا محمد استغفر لهم فإني قد غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم، واعف عنهم فإني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم، وهذا يدل على كمال رحمة الله لهذه الأمة…»
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
قال الإمام القشيري -رحمه الله تعالى- في لطائفه: «فَاعْفُ عَنْهُمْ فاعف- أنت- عنهم فإن حكمك حكمُنا، فأنت لا تعفو إلا وقد عَفَوْنا، ثم ردَّه عن هذه الصفة بما أثبته في مقام العبودية، ونقله إلى وصف التفرقة فقال: ثم قِفْ في محل التذلل مبتهلًا إلينا في استغفارهم. وكذا سُنَّتُه سبحانه مع أنبيائه عليهم السلام وأوليائه، يردُّهم مِنْ جمعٍ إلى فرقٍ ومن فَرْقٍ إلى جمع، فقوله: فَاعْفُ عَنْهُمْ {جمع، وقوله: وَاسْتَغْفِرْ لهُمْ فرق.
ويقال: فَاعْفُ عَنْهُمْ وتجاوز عنهم في حقوقك، ولا تكتفِ بذلك ما لم تستغفِرْ لهم إكمالًا للكرم؛ ولهذا كان يقول: “اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون”.
ويقال ما يُقصِّرون في حقِّك تعلَّق به حقَّان: حقك وحقي، فإذا عفوتَ أنت فلا يكفي هذا القَدْرُ بل إنْ لَمْ أتجاوز عنهم في حقي كانوا مستوجبين للعقوبة؛ فمن أرضى خصمَه لا يَنْجَبِر حالُه ما لم يغفر الله له فيما ترك من أمره.
وقوله وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر أي أثْبِتْ لهم محلًا؛ فإنَّ المعفوَ عنه في صدار الخجلة لا يرى لنفسه مقام الكَرامة، فإذا شاورتَهم أزَلْت عنهم انكسارهم، وطيَّبْتَ لهم قلوبهم «.
وإنّها لإشارة عجيبة والتفاتة طيبة هذه التي ذكرها، فإن من يرتكب خطأ فادحا ويشعر بهول نتائجه ليخجل خجلا ما له نظير… فينكسر قلبه ويحسّ بالمهانة ولا يرى نفسه أهلا لمقام الحضور فكيف بمقام الاستشارة.
لكن المولى الكريم إذا أعطى أبهر وإذا جاد حيّر… فبما رحمة منه –سبحانه- كما ألان لهم قلب رسوله فما عاتب ولا جرح، أمره بأن يعفو عنهم ويسمح، ويستغفر لهم ويصفح، ويستشيرهم في الأمر فإن من استشار أفلح.
قال الإمام البغوي –رحمه الله تعالى-: «وشاورهم في الأمر أي: استخرج آراءهم واعلم ما عندهم من قول العرب: شرت الدابة وشورتها إذا استخرجت جريها، وشرت العسل وأشرته إذا أخذته من موضعه واستخرجته .»
ولله درّ الحسن البصري-رحمه الله تعالى- فقد انتبه إلى فائدة عظيمة واستخرج درّة كريمة فقال: «قد علم الله عز وجل أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة ولكنه أراد أن يستن به من بعده.»
وكأنما يقول ربّنا سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام إيّاك أن تترك مبدأ الشورى وتتخلى عن هذه الدعامة الكبرى… إياك أن تغلق باب التشاور فيُفتح باب الاستبداد، ويتقهقر نظام الحكم ويستشري الفساد، ويجثم المستكبرون على رقاب العباد…
حقّا لقد أفضت الشورى في غزوة أحد إلى نتائج سلبية… فقد كان رأي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم خيرا من رأي من معه… لكن الشورى أفضت إلى غير ما كان يميل إليه… والنتيجة كانت تراجع ثلث الجيش قبل بداية الحرب، ثمّ هزيمة في الغزوة واستشهاد عمِّه حمزة وثلّةٍ من خيرة أصحابه رضي الله عنهم… لكن هذا كلّه لا يعطيه الحقّ في أن يستأصل أساسا من أسس النظام الإسلامي وناظمة من نواظمه الثلاث…
وكم هو جميل ما صدر عن الشيخ الشعراوي –رحمه الله تعالى- في خواطره: «…لا تقل: استشرتهم وطاوعتهم في المشورة، وبعد ذلك حدث ما حدث، فتكره أن تشاورهم، لا تقفل هذا الباب برغم ما حدث نتيجة تلك المشورة وأنَّها لم تكن في صالح المعركة، فالعبرة في هذه المشقة هي أن تكون “أحدُ” معركة التأديب، ومعركة التهذيب، ومعركة التمحيص، إذن فلا ترتّب عليها أن تكره المشورة، بل عليك أن تشاورهم دائما، فما دام العفوُ قد رضيَتْ به نفسُك، وما دُمت تستغفر لهم ربَّك-واستغفارك ربّك قد تستغفره بعيدا عنهم- وعندما تشاورهم في أي أمر من بعد ذلك فكأن المسألة الأولى انتهت، وما دامت المسألة الأولى قد انتهت، فقد استأنفنا صفحة جديدة، وأخذنا الدرس والعظة التي ستنفعنا في أشياء كثيرة بعد ذلك.»
وأجمل منها هذه السوانح التي جادت بها قريحة الشهيد سيد قطب في الظلال: «وبهذا النص الجازم وشاورهم في الأمر يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم – حتى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولاه. وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه.. أما شكل الشورى، والوسيلة التي تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها. وكل شكل وكل وسيلة، تتم بها حقيقة الشورى – لا مظهرها – فهي من الإسلام.
لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة! فقد كان من جرائها ظاهريا وقوع خلل في وحدة الصف المسلم! اختلفت الآراء. فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها، حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة. وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين. وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف. إذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، والعدو على الأبواب – وهو حدث ضخم وخلل مخيف – كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن – في ظاهرها – أسلم الخطط من الناحية العسكرية. إذ أنها كانت مخالفة “للسوابق” في الدفاع عن المدينة – كما قال عبد الله ابن أبي – وقد اتبع المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية، فبقوا فعلا في المدينة، وأقاموا الخندق، ولم يخرجوا للقاء العدو. منتفعين بالدرس الذي تلقوه في أحد!
ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من جراء الخروج. فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة، التي رآها، والتي يعرف مدى صدقها. وقد تأولها قتيلا من أهل بيته، وقتلى من صحابته، وتأول المدينة درعا حصينة.. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة للشورى.. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات. لأن إقرار المبدأ، وتعليم الجماعة، وتربية الأمة، أكبر من الخسائر الوقتية.
ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة. أمام ما أحدثته من انقسام في الصفوف في أحرج الظروف؛ وأمام النتائج المريرة التي انتهت إليها المعركة! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة، ويربيها، ويعدها لقيادة البشرية. وكان الله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمم وإعدادها للقيادة الرشيدة، أن تربى بالشورى؛ وأن تدرب على حمل التبعة، وأن تخطئ – مهما يكن الخطأ جسيما وذا نتائج مريرة – لتعرف كيف تصحح خطأها، وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها. فهي لا تتعلم الصواب إلا إذا زاولت الخطأ.. والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة. واختصار الأخطاء والعثرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيها شيء من الكسب لها، إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل تحت الوصاية. إنها في هذه الحالة تتقي خسائر مادية وتحقق مكاسب مادية. ولكنها تخسر نفسها، وتخسر وجودها، وتخسر تربيتها، وتخسر تدريبها على الحياة الواقعية. كالطفل الذي يمنع من مزاولة المشي – مثلا – لتوفير العثرات والخبطات. أو توفير الحذاء!
كان الإسلام ينشئ أمة ويربيها، ويعدها للقيادة الراشدة. فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها، ويرفع عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية، كي تدرب عليها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبإشرافه. ولو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى، ويمنع تدريب الأمة عليها تدريبا عمليا واقعيا في أخطر الشؤون – كمعركة أحد التي قد تقرر مصير الأمة المسلمة نهائيا، وهي أمة ناشئة تحيط بها العداوات والأخطار من كل جانب – ويحل للقيادة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخطورة – لو كان وجود القيادة الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون، لكان وجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى – كافيا لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى! – وبخاصة على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة. ولكن وجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلك الأحداث، ووجود تلك الملابسات، لم يلغ هذا الحق. لأن الله – سبحانه – يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون، ومهما تكن النتائج، ومهما تكن الخسائر، ومهما يكن انقسام الصف، ومهما تكن التضحيات المريرة، ومهما تكن الأخطار المحيطة.. لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة، المدربة بالفعل على الحياة؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل، الواعية لنتائج الرأي والعمل.. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي، في هذا الوقت بالذات “فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر”»
يقول الشاعر:
شاور سواك إذا نابتك نائبة ** يوما وإن كنت من أهل المشورات
فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ** ولا ترى نفسها إلا بمرآة
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
وليست الشورى إلا تقليبا لوجهات النظر، وتلاقحا للآراء والأفكار، ومحاولة لاختيار أفضل الاتجاهات المعروضة… هذا دور الشورى وهنا ينتهي عملها… ولا بدّ بعد ذلك من المرور إلى عملية التنفيذ… تنفيذ يشارك فيه الجميع دون تردد ولا معارضة… تنفيذ في عزم وحسم ومضاء متوكلين على من بيده ملكوت كلّ شيء، مفوضين له الأمر في اختيار النتائج، راضين تمام الرضا بما قسّم وقدّر… وليصغ سبحانه العواقب كيفما يشاء.
وأختم بهذه الإشارة الجامعة الماتعة التي سطرتها يد الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة في البحر المحيط:
«الإشارة: ما اتصف به نبينا – عليه الصلاة والسلام – من السهولة والليونة والرفق بالأمة، اتصفت به ورثته من الأولياء العارفين، والعلماء الراسخين، ليتهيأ لهم الدعوة إلى الله، أو إلى أحكام الله، ولو كانوا فظاظاً غلاظاً لانفض الناس من حولهم، ولم يتهيأ لهم تعريف ولا تعليم، فينبغي لهم أن يعفوا ويصفحوا ويغفروا ويصبروا على جفوة الناس، ويستغفروا لهم، ويشاوروهم في أمورهم، اقتداء برسولهم، فإذا عزموا على إمضاء شيء فليتوكلوا على الله إن الله يحب المتوكلين.»
وصلى الله وسلّم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.