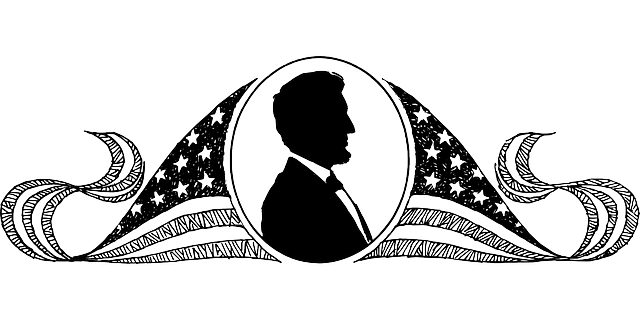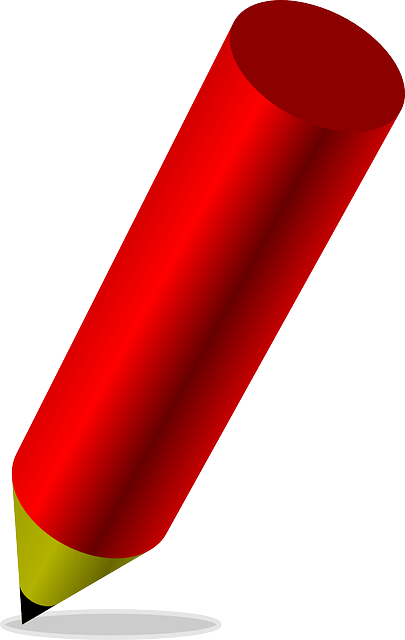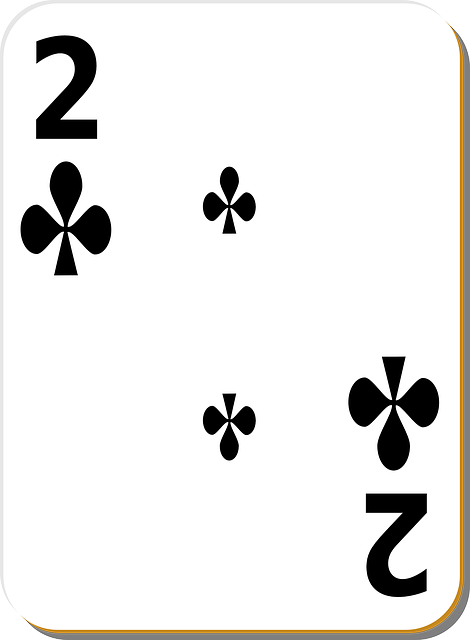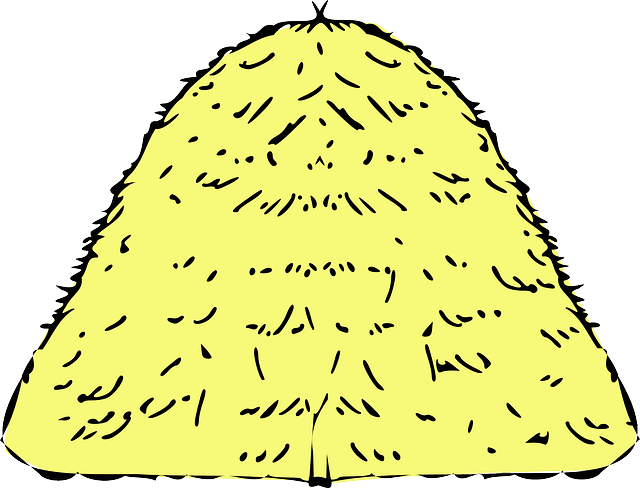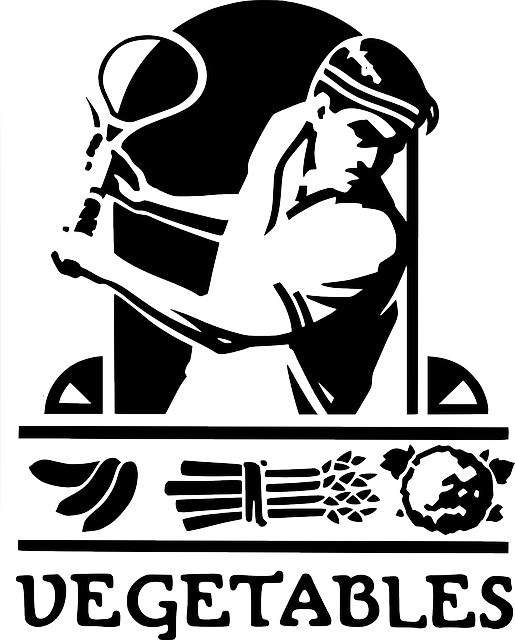زÙارة اÙرئÙس اÙصÙÙÙ ÙÙ ÙØ·ÙØ© اÙØ®ÙÙج ÙتØدÙدا٠اÙسعÙدÙØ© Ùاجت٠اع٠٠ع Ùادة عرب بثÙاث Ù٠٠سعÙدÙØ©-صÙÙÙØ© ÙØ®ÙÙجÙØ©-صÙÙÙØ© ÙعربÙØ©-صÙÙÙØ© عÙ٠اÙترتÙب Ùؤشر عÙ٠أ٠Ùذ٠اÙزÙارة ÙÙست ÙسابÙاتÙا ب٠تؤسس Ù٠رØÙØ© جدÙدة ÙÙا ٠ا بعدÙا ÙÙ٠ا ÙتعÙ٠باÙتعاÙ٠اÙ٠شتر٠بÙ٠اÙعاÙ٠اÙعرب٠ÙÙ٠اÙÙÙب Ù Ù٠اÙØ®ÙÙج ÙبÙ٠ثاÙ٠أÙبر اÙتصادات اÙعاÙÙ ÙاÙÙÙØ© اÙطا٠ØØ© ÙÙعب دÙر Ø£Ùثر صرا٠ة Ù٠اÙÙظا٠اÙدÙÙ٠تØت زعا٠ة اÙرئÙس تشÙ.
Ø°Ùبت تØÙÙÙات غربÙØ© Ø¥ÙÙ Ùضع اÙزÙارة Ù٠سÙا٠٠ØاÙÙات اÙصÙ٠إعادة ت٠ÙضعÙا ÙÙ Ùظا٠عاÙÙ Ù ÙØ´Ùد اختÙاÙات جÙÙرÙØ© باÙبÙاء اÙدÙÙÙ Ù٠ظ٠تراجع ÙÙÙØ° اÙÙÙاÙات اÙ٠تØØ¯Ø ÙاÙØرب اÙدائرة بÙ٠رÙسÙا ÙØ£ÙÙراÙÙا اÙت٠تعÙد تعرÙ٠أÙرÙبا Ù٠اÙÙظا٠اÙعاÙÙ Ù Ù Ù ØÙØ« تبعÙتÙا ÙÙاشÙØ·Ù ÙدÙرÙا باÙترتÙبات اÙØ£Ù ÙÙØ© اÙعاÙÙ ÙØ©.
بÙÙÙ Ø© أخر٠Ùا٠اÙØدÙØ« ÙÙÙ Ùذ٠اÙتØÙÙÙات ÙدÙر ØÙ٠تØرÙ٠اÙصÙÙ ÙÙاØدة ٠٠أØجارÙا عÙ٠رÙعة اÙشطرÙج ÙÙاعب عاÙÙ Ù ÙÙ ØÙ٠ظÙرت اÙÙ ÙØ·ÙØ© اÙعربÙØ© ٠جرد ساØØ© Ùعب ÙÙ Ù ØاÙÙØ© ÙإضÙاء اÙسÙبÙØ© عÙ٠اÙÙ ÙÙ٠اÙعرب٠ÙاÙØ®ÙÙج٠٠Ù٠عÙÙ Ùج٠اÙتØدÙد.
ÙÙÙ٠باÙÙظر Ø¥Ù٠تÙاصÙ٠اÙÙ٠٠اÙØ«Ùاث Ùجد -عÙ٠عÙس Ø°ÙÙ- اÙدÙر اÙعرب٠بÙÙادة اÙسعÙدÙØ© Ùا٠Ù٠دÙر ÙبÙر بÙÙدسة اÙزÙارة ÙبÙاء أجÙدتÙا. ÙÙ Ùاب٠اÙصÙ٠اÙت٠تØاÙ٠أ٠تعزز Ù Ù ØضÙرÙا Ù٠اÙساØات اÙØÙÙÙØ© ØÙ٠اÙعاÙ٠٠ث٠اÙØ®ÙÙج اÙعربÙØ ØªÙجد اÙسعÙدÙØ© (ÙدÙ٠اÙØ®ÙÙج) اÙت٠تØاÙ٠أ٠تتØرر ٠٠اÙÙصاÙØ© اÙأ٠رÙÙÙØ© اÙتÙÙÙدÙØ© ÙتÙÙع Ø®ÙاراتÙا باÙتعاط٠٠ع اÙدÙ٠اÙÙبر٠Ùض٠ا٠٠صاÙØÙا Ù٠اÙÙ Ùا٠اÙØ£ÙÙ. ÙاÙصÙÙ Ù٠تعد دÙÙØ© Ø¥ÙÙÙÙ ÙØ© ÙبرÙØ Ø¨Ù Ø¨Ø§ØªØª تØظ٠ب٠ÙاÙØ© اÙدÙ٠اÙعظ٠٠Ù٠اÙÙظا٠اÙدÙÙÙØ ÙÙØ°ÙÙ Ùإ٠اÙتØر٠باتجا٠ÙØªØ Ø¹ÙاÙات بÙاءة ٠عÙا Ùعد Ø£Øد أبرز ٠عاÙ٠اÙÙظا٠اÙعاÙÙ Ù Ù٠اÙØÙبة اÙÙ ÙبÙØ©.
Ùا ش٠أ٠اÙعاÙ٠بدأ Ùدخ٠٠رØÙØ© ٠ا ÙÙ Ù٠أ٠ÙØ·Ù٠عÙÙ٠اÙØرب اÙباردة اÙÙسخة اÙثاÙÙØ© (Cold War 2.0) بÙ٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة ÙØÙÙائÙا اÙغربÙÙ٠٠٠جÙØ© ÙبÙ٠اÙصÙÙ ÙشرÙائÙا (إذا ØµØ Ø§ÙتعبÙر). غÙر أ٠أبرز ٠عاÙÙ Ùا ÙÙ ÙسختÙا اÙثاÙÙØ© Ø£ÙÙا ÙÙست Ø«ÙائÙØ© اÙÙطب ب٠٠تعددة ÙÙا تØدث عÙ٠خطÙØ· اÙصدع بÙ٠اÙ٠عسÙر اÙغرب٠ÙاÙ٠عسÙر اÙشرÙÙ. ÙطبÙعة اÙØ£ØÙا٠ÙÙس صÙرÙØ© ÙÙÙ ÙÙ ÙÙدÙ٠اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ© اÙÙبر٠ÙاÙسعÙدÙØ© ÙترÙÙا Ù٠صر (عÙ٠سبÙ٠اÙ٠ثاÙ) اÙتØر٠ب٠رÙÙØ© بÙ٠اÙدÙ٠اÙعظ٠٠٠٠غÙر Ø¥Øداث ÙØ·Ùعة ٠ع Ø¥ØداÙا أ٠٠عاداتÙا.
رب٠ا Ø£Ùبر ٠ثا٠عÙÙ Ø°Ù٠ترÙÙا. ٠ؤخرا٠ÙخصÙصا٠٠ÙØ° اÙدÙاع اÙØرب بÙ٠رÙسÙا ÙØ£ÙÙراÙÙا أبدت Ø£ÙÙرة ٠رÙÙØ© بتعا٠ÙÙا ٠ع اÙدÙ٠اÙÙبرÙ. ÙÙ٠تصط٠٠ع اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة ÙØÙÙائÙا اÙغربÙÙÙ ÙÙ ØÙ٠أداÙت اÙاجتÙØ§Ø Ø§ÙرÙس٠ÙطاÙبت بÙÙØ© باØترا٠سÙادة اÙأراض٠اÙØ£ÙÙراÙÙØ© ÙÙØدتÙا ÙÙعÙÙÙت اتÙاÙÙات اÙÙ ÙاØØ© اÙعسÙرÙØ© ب٠ضÙÙÙ٠اÙبسÙÙر ÙاÙدردÙÙ٠تجا٠عد٠استغÙاÙÙا ٠٠اÙÙÙات اÙ٠تØاربة. ÙأبÙت ترÙÙا عÙ٠تØاÙÙÙا ٠ع اÙغرب (ØÙ٠اÙÙاتÙ) ÙعÙاÙاتÙا ٠ع رÙسÙا Ù Ù Ø®Ùا٠اÙÙÙاءات رÙÙعة اÙ٠ستÙ٠اÙت٠ج٠عت بÙ٠اÙبÙدÙÙ. أسÙرت Ùذ٠اÙسÙاسة ع٠تØÙÙ٠ترÙÙا اختراÙات عÙ٠اÙ٠ستÙ٠اÙدبÙÙ٠اس٠Ùا٠أبرزÙا اتÙاÙÙØ© اÙØبÙب ÙاتÙاÙÙات تباد٠اÙأسرÙ.
طبÙعة اÙØ£ØÙا٠ÙÙس صÙرÙØ© ÙÙÙ ÙÙ ÙÙدÙ٠اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ© اÙÙبر٠ÙاÙسعÙدÙØ© ÙترÙÙا Ù٠صر (عÙ٠سبÙ٠اÙ٠ثاÙ) اÙتØر٠ب٠رÙÙØ© بÙ٠اÙدÙ٠اÙعظ٠٠٠٠غÙر Ø¥Øداث ÙØ·Ùعة ٠ع Ø¥ØداÙا أ٠٠عاداتÙا.
اÙسعÙدÙØ© Ø£Ùضا٠تع٠جÙدا٠اÙتØÙÙات اÙجÙÙرÙØ© Ù٠دÙÙا٠ÙÙÙات اÙÙظا٠اÙدÙÙÙ. ÙبدÙا٠٠٠اÙاÙÙÙاء عÙ٠اÙسÙاسة اÙتÙÙÙدÙØ© اÙت٠تر٠Ù٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة (اÙغرب) اÙØÙÙ٠اÙÙØÙØ¯Ø Ø¨Ø¯Ø£Øª اÙرÙاض سÙاسة خارجÙØ© Ø£Ùثر ٠رÙÙØ© بتÙÙÙع Ø®ÙاراتÙا. ÙÙ٠ا Ùا٠أØد اÙدبÙÙ٠اسÙÙ٠اÙسعÙدÙÙÙ ÙاصÙا٠عÙاÙØ© اÙسعÙدÙØ© ٠ع اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة بأÙÙا ÙÙست زÙاجا٠ÙاثÙÙÙÙÙا٠ÙÙتÙÙ ÙÙ٠اÙزÙج بÙاØØ¯Ø©Ø Ø¨Ù Ø²Ùاج إسÙا٠٠٠شرÙع ÙÙ٠اÙØªØ¹Ø¯Ø¯Ø Ùإ٠اÙسعÙدÙØ© أصبØت Ù٠ظ٠ÙÙادة شابة تر٠ÙجÙب اÙتعدد خصÙصا٠Ù٠ظ٠بÙئة دÙÙÙØ© ٠تغÙرة بشÙÙ ÙØ§Ø¶Ø ÙسرÙع.
ÙÙ ÙظÙر ع٠اÙسعÙدÙØ© أ٠٠ؤشرات ØÙÙ ÙÙتÙا اÙتخÙ٠ع٠تØاÙÙÙا ٠ع اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة. ÙÙا Ùزا٠Øج٠اÙ٠صاÙØ Ø§Ùت٠تج٠عÙ٠ا ÙبÙراÙ. ÙاÙسعÙدÙØ© تعت٠د Ù٠٠جاÙÙ٠اÙØ£Ù Ù ÙاÙتسÙÙØ Ø¨Ø´ÙÙ ÙبÙر عÙ٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة. ÙاÙدÙÙØ© اÙÙØÙدة اÙت٠Ùا تزا٠تض٠٠أ٠٠اÙÙ ÙاØØ© Ù٠اÙØ®ÙÙج Ù٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة خصÙصا٠عبر أسطÙÙÙا اÙخا٠س اÙØ°Ù Ùتخذ ٠٠اÙبØرÙÙ Ù Ùرا٠ÙÙ. ÙÙ ØÙ٠تشÙ٠اÙسعÙدÙØ© شرÙÙا٠جÙÙرÙا٠ÙÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© سÙاء تجا٠اÙÙ ØاÙظة عÙ٠استÙرار سÙ٠اÙطاÙØ© اÙعاÙÙ ÙØ© Ø£Ù Ù Øاربة ٠ا Ùس٠٠"اÙإرÙاب".
غÙر Ø£Ù Ùذ٠اÙتØاÙÙ Ùا Ùأخذ اÙØ´Ù٠اÙرÙ٠اÙس٠Ù٠ج٠Ùع ٠راØÙÙ. ÙدÙÙØ© ÙاÙضة تØتاج اÙسعÙدÙØ© Ø¥Ù٠اÙتØرر ٠٠بعض اÙÙÙÙد اÙت٠ÙÙرضÙا اÙاÙتÙاء بØÙÙÙ ÙاØد. ÙÙ ÙÙات ØÙÙ٠اÙØ¥Ùسا٠Ùتضارب اÙرؤ٠اÙداخÙÙØ© بÙ٠اÙدÙÙ ÙراطÙÙÙ ÙاÙج٠ÙÙرÙÙ٠تجا٠عÙاÙØ© ÙاشÙØ·Ù ÙاÙرÙاض ÙتØرÙÙر أ٠رÙÙا Ù Ù Ùبضة اÙÙÙØ· اÙØ®ÙÙج٠Ùجع٠٠٠اÙ٠راÙÙØ© عÙÙ Ùذا اÙتØاÙÙ Ù٠ج٠Ùع اÙÙ Øطات ضربا٠٠٠اÙ٠خاطرة.
بÙاء عÙÙ Ø°Ù٠تجد اÙسعÙدÙØ© ضرÙرة تعدد اÙØÙÙاء أ٠اÙشرÙاء عÙ٠أÙ٠تÙدÙر. ÙÙÙ Ùذا اÙسÙا٠Ùا ÙÙ Ù٠غض اÙطر٠ع٠اÙصÙÙ ÙÙ٠اÙدÙ٠اÙÙاÙضة بÙÙØ© ÙاÙت٠أصبØت ثاÙ٠أÙبر اÙتصاد عاÙÙ Ù. بشÙ٠عا٠Ùخد٠اÙتÙارب ٠ع اÙصÙÙ ÙدÙÙ٠جÙÙرÙÙÙ ÙÙسعÙدÙØ©.
ÙÙذا اÙتÙارب Ùعط٠Ùا٠شا٠أÙسع ÙÙرÙاض ÙÙتØر٠عÙ٠خطÙØ· اÙصدع بÙ٠اÙدÙ٠اÙÙبر٠ÙÙعزز ÙÙ٠تÙا اÙاستراتÙجÙØ© Ù٠اÙØسابات اÙدÙÙÙØ© ÙÙذ٠اÙدÙÙ. ÙÙÙ Ù Ù ÙاشÙØ·Ù ÙبÙÙÙ ÙØرص عÙ٠أ٠Ùخطب Ùد اÙرÙاض بعدد ٠٠اÙÙ ÙÙات خصÙصا٠اÙطاÙØ©Ø Ø¥Ø° تعززت ÙÙÙ Ø© اÙسعÙدÙØ© ÙÙ Ùذا اÙÙ Ù٠بعد اÙصد٠ة اÙت٠تعرضت ÙÙا أسÙا٠اÙطاÙØ© اÙعاÙÙ ÙØ© عÙ٠إثر اÙØرب اÙدائرة بÙ٠رÙسÙا ÙØ£ÙÙراÙÙا.
أ٠ا ثاÙÙا٠Ùإ٠اÙسعÙدÙØ© بØاجة Ø¥Ù٠تسرÙع ٠شارÙع تصب Ù٠خد٠ة خطتÙا اÙØ·Ù ÙØØ© ÙرؤÙØ© 2030 خصÙصا٠باÙØ¥Ùشاءات ÙاÙتÙÙÙÙÙجÙا ÙاÙصÙاعات اÙÙÙÙÙØ©. تعد اÙصÙ٠اÙآ٠اÙشرÙ٠اÙتجار٠اÙØ£ÙÙ ÙÙسعÙدÙØ©Ø Ùتعد اÙسعÙدÙØ© اÙÙ ÙرÙÙد اÙØ£Ùبر ÙÙÙÙØ· Ø¥Ù٠اÙصÙÙ. Ùتع٠٠اÙشرÙات اÙصÙÙÙØ© عÙ٠تطÙÙر اÙبÙÙØ© اÙتØتÙØ© ÙÙ٠شرÙعات اÙÙÙÙÙØ© اÙسعÙدÙØ© ÙÙ ØÙ٠تساÙ٠بتعزÙز Ùدرات اÙسعÙدÙØ© Ù٠تÙÙÙÙÙجÙا اÙصÙارÙØ® اÙباÙستÙØ© ÙاÙÙ ÙسÙرات.
Ù٠اÙختا٠Ùعد اÙÙÙج اÙ٠ر٠ببÙاء اÙتØاÙÙات ÙاÙتØر٠عÙ٠خطÙØ· اÙصدع بÙ٠اÙدÙ٠اÙÙبر٠٠٠دÙ٠إÙÙÙÙ ÙØ© ÙاÙسعÙدÙØ© ÙترÙÙا ÙÙجا٠Ùؤسس Ù٠عاÙ٠اÙÙظا٠اÙعاÙ٠٠باÙ٠ستÙب٠اÙÙرÙب. ÙأعتÙد Ø£ÙÙ ÙØتاج Ø¥Ù٠٠زÙد تسÙÙØ· ضÙØ¡ Ùدراسة ÙØ£ÙÙ Ùت٠ÙÙس بتØدÙد طبÙعة اÙتØاÙÙات ÙØسب ÙÙÙÙ Ù٠٠عادÙØ© اÙØ£Ù Ù ÙاÙاستÙرار اÙدÙÙÙÙÙ.
ج٠Ùع اÙÙ ÙاÙات اÙÙ ÙØ´Ùرة تعبÙر ع٠رأ٠ÙÙتÙابÙا ÙÙا تعبÙر باÙضرÙرة ع٠TRT عربÙ.