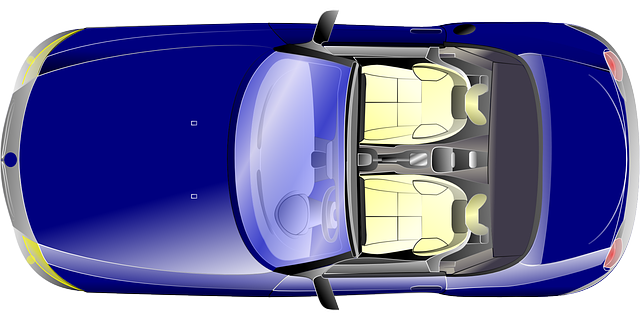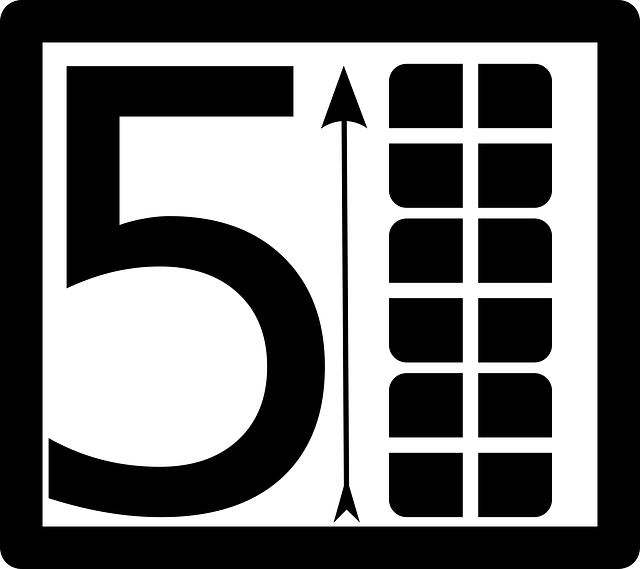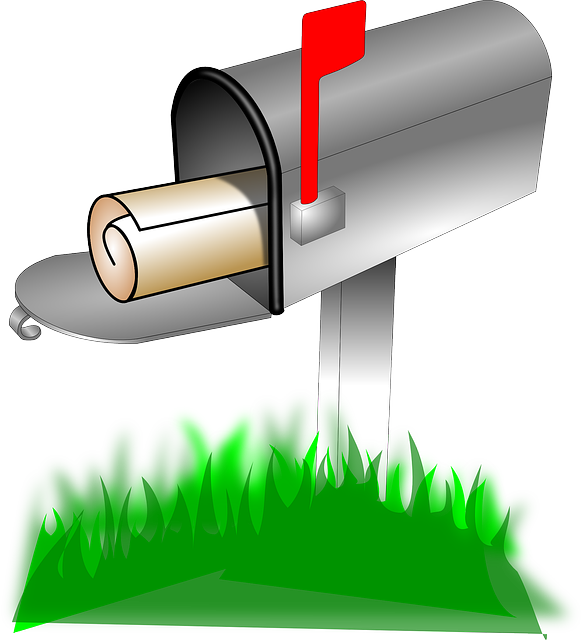وائل لطفى يحاور إبراهيم عبدالمجيد (4-2): بحثت عن وظيفة يمكن «التزويغ» منها حتى أتفرغ للكتابة
وائل لطفى يحاور إبراهيم عبدالمجيد (4-2): بحثت عن وظيفة يمكن «التزويغ» منها حتى أتفرغ للكتابة
سعدالدين وهبة عيننى فى الثقافة الجماهيرية دون سابق معرفة ورفضت العمل فى الصحافة
بعد مظاهرات يناير وجدت أن قصصى تحولت لمنشورات سياسية فاستقلت من التنظيم اليسارى الذى كنت عضوًا فيه
سافرت للسعودية لمدة عام وعندما جمعت ثمن الشقة عدت على الفور
محمود درويش فتح لى أبواب العالم العربى وعوضنى عن التضييق علىّ فى مصر
فى عام ٢٠١٨ كنت أكتب عن أحد كبار كتابنا من جيل الستينيات، ووجدت أنى أشعر بالخوف! كان خوفى إن بننسى تكريم كبار مبدعينا فى غمرة الحماس لتمكين الشباب! وفى غمرة الحراك الجيلى فى المجتمع.. وفى غمرة الظواهر الجديدة فى الكتابة الأدبية ومعاييرها الجديدة.. لذلك كتبت أطالب بتكريم كل من تبقى من كبار مبدعينا من جيل الستينيات.. وسرعان ما أجابت الأيام عن مخاوفى.. وحصل معظم مبدعى هذا الجيل على أرفع جوائز الدولة التقديرية.. وكان على رأسهم العم إبراهيم عبدالمجيد.. الأديب الكبير، والمصرى الطيب، وصاحب التجربة العصامية الكبيرة فى الحياة، والكتابة، وتحمل الصعاب، والإخلاص للكتابة على مدى خمسة عقود متواصلة أو أكثر قليلًا.. كان بيننا موعد مؤجل منذ شهور. لكنه ما إن أعلن فوزه بالجائزة حتى ذهبت إليه لأحتفل معه وأسمع منه تفاصيل رحلة كفاح فى الحياة والكتابة والأمل.. أظن أنها تحمل الكثير من المعانى للأجيال الشابة والقادمة.. فإلى الحلقة الثانية من حوار الذكريات..
■ س: كيف سارت حياتك بعد أن انتقلت للقاهرة وتركت الإسكندرية.. وكيف واصلت الكتابة؟
- ج: بدأت أتعرف فى القاهرة مع النشر والتواجد فى ريش، عرفونى الأدباء بعد كده فى القاهرة، لأن الذى تُنشر له قصة فى الطليعة كان يُنظر له على أنه شخص مهم، لأن عدد الكتّاب كان قليلًا، فكنا نجلس فى مقهى «ريش» أنا وسليمان فياض، وأمل دنقل وبهاء طاهر، وقبل أن أعمل موظفًا فى الثقافة الجماهيرية، كنت فى منظمة الشباب لفترة، فاختارونى فى دور «موجه سياسى» أو محاضر، فعملت سنتين قبل الفصل من المنظمة بتهمة أنى ماركسى أيام الرئيس محمد أنور السادات، ففصلنى عبدالحميد حسن أمين عام المنظمة على أساس أننا شيوعيون نريد اختراق المنظمة، كنا نذهب للمعسكرات المختلفة فى أبوقير وغيرها من المصايف ثم نعود لنقيم فى الزمالك، فى نفس المقر الذى أصبح مقر اتحاد الكتاب فيما بعد، وكان فيه مكان مخصص لإقامة الموجهين السياسيين.
وقتها تلقيت عرضًا للعمل فى جريدة الأهرام، ولكن رفضت العمل فى الصحافة، قلت لهم لا أريد عملًا فيه التزام، أريد وظيفة أستطيع «التزويغ» منها كى أكتب.
فقلت سوف أذهب للثقافة الجماهيرية، وبالفعل ذهبت لسعدالدين وهبة رئيس الهيئة وقتها، وكانت هذه المرة الأولى التى أراه فيها، وقلت له أنا نشرت قصصًا فى الهلال والمجلة والطليعة، وحكيت له قصتى، فقال اكتب طلبًا، وأشر عليه بالموافقة فورًا، وذهبت لأسحب ملفى من الترسانة البحرية فوجدت الشاعر أحمد الحوتى، وهو سكندرى وكان مديرًا فى الثقافة الجماهيرية، فقال لى ستعمل معى فى قصر ثقافة الريحانى بدلًا من إدارة العلاقات العامة التى كان تعيينى عليها، وبالفعل أقمت معه، فى مصر الجديدة، فى بنسيون تملكه سيدة أجنبية، وعملت معه فى قصر ثقافة الريحانى فى حدائق القبة، كنت لا أحب القاهرة كمدينة ولكن مضطر لأن أعيش فيها، لذلك كنت أنام معظم ساعات النهار هربًا من زحام القاهرة، وأعمل فى المساء فى إدارة الندوات فى القصر، وبعد الندوة نسهر للصباح أنا وأصدقائى، فلم أتعذب بنهارات القاهرة، وأظن لو فرض علىّ مديرى أن أعمل بالنهار كنت سأعود للإسكندرية.
وتركت السكن مع أحمد الحوتى، وقابلت المخرج سامى صلاح وسكنت معه وكانت أيام صعلكة رائعة، وعندما علمت أنه توفى عام ٢٠١١، كتبت رواية كاملة ضمنتها بعض أيامنا معًا، وكان سامى مخرجًا رائعًا يعد ويؤلف مسرحيات من المسرح العالمى والتراث، وكنا عضوين فى مجموعة منها المطرب «عدلى فخرى» والشاعر «سمير عبدالباقى» وكانا ثنائيًا فنيًا مثل «نجم»، و«الشيخ إمام»، وكان معنا كثير من شعراء السبعينيات مثل أمجد ريان وحلمى سالم.
وفى عام ١٩٧٧ عندما قامت مظاهرات يناير تم تغيير المدير، وجاء مدير لم يعجبه ما نقوم به من أنشطة فتركت قصر الريحانى، وعملت فى العلاقات العامة بالإدارة الرئيسية، وترك الحوتى أيضًا القصر، وعملت فى تنظيم مهرجانات للفن الشعبى وأحسن مهرجان كان فى شهر رمضان، فى الحسين بالدراسة مكان مشيخة الأزهر حاليًا، قبل بنائها، فكنا ننظم شادرًا كبيرًا جدًا، ونستضيف فنانين كثيرين، فكنت أقدمهم للغناء بعد الإفطار، وقدمنا فنانين كثيرين، منهم المطربة أنغام وكانت لا تزال طفلة، وكثير جدًا من المطربين الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد، وكانت أيامًا جميلة ورائقة نسهر فيها للصباح ونتبادل المودة والضحك.
■ فى ظل هذه الأجواء والسهر والحفلات.. متى كنت تكتب؟
- كنت أكتب بعد الفجر حتى يطلع النهار، وكنت أنام فى الصباح ٦ أو ٧ لأنى لا أذهب للعمل فى النهار، واكتسبت خبرات كبيرة من عالم السهر والصحبة فى الليل، وقتها كنت عضًوا فى «الحزب الشيوعى المصرى» وكان الحزب سريًا، وكنت فى خلية بها عدد كبير من المبدعين، وكنت مسئول الاتصال مع اللجنة المركزية، ففى هذه الفترة ما بعد مظاهرات ١٩٧٧، كنت عندما أكتب قصة أشعر بأنها سيئة فنيًا وبها أفكار سياسية زاعقة وكأنها منشور سياسى، فقررنا كلنا أن نترك الحزب فى يوم واحد، لأن السياسة غلبت الفن فى كتاباتنا، وهذا خطأ كبير، فتركنا الحزب وكل واحد فينا سافر لبلد عربى ليعمل فيه، أنا ذهبت للسعودية وهناك من ذهب للكويت.. وهكذا، وأقسمنا أننا لن ندخل أحزابًا سياسية مرة أخرى لأن هدفنا كان تقديم كتابة جيدة.
وقتها كانت لدىّ رواية لم تنشر عن نكسة ١٩٦٧، لم أكملها وبدأت فى كتابة رواية «المسافات».. وجلست مع الأديب عبدالوهاب الأسوانى، قبل أن أبدأ كتابة «المسافات» بيومين، وحكيت له عن الحزب، وإن السياسة غالبة على الفن فى كتابتى وأننى أشعر بالحيرة بين السياسة والفن، فقال لى يا إبراهيم هناك ألف واحد يوزع منشورات لكن لا يوجد ألف واحد موهوب، امشى ومش هيزعلوا، فتركت الحزب، وقلت إذا كان مطلوبًا منى أن أغير العالم فلأغير الشقة البسيطة التى أسكن فيها أولًا!
ثم سافرت إلى السعودية وبعدها بشهرين ثلاثة وجدت نفسى أكتب الكتابة التى أريدها، وأقول لنفسى وجدتها.. وأرقص من الفرح كلما كتبت صفحة تعجبنى.. وعملت فى تبوك فى شركة من شركات الشيخ صالح كامل، رحمه الله، فعملت سنة واحدة فقط وكان هدفى شراء شقة أو شقة إيجار فى القاهرة، كنت أريد منزلًا حسن الإضاءة، يصلح للاستقرار، لأن السكن فى الغرف المفروشة يجعل الأصدقاء والباحثين عن مكان يأتون لك دون موعد فتضطر للجلوس معهم وتؤجل الكتابة، وهذا لا يحدث فى المنزل الخاص.
■ هل كان عندك وعى إن الكتابة أهم من النقود وبالتالى لم تستمر فى الغربة كثيرًا؟
- بالتأكيد كان عندى هذا الوعى، فعندما رجعت من السعودية قابلت صديقى «صنع الله إبراهيم»، فقال إنت تركت «الفلوس» ورجعت، قلت له عايز أكتب مش عايز فلوس، فقال يا لئيم فقلت له بتحسدنى على الفقر يا إبراهيم؟!، وضحكنا، أنا تأملت أحوال المصريين فى الخليج فوجدت أن الكثير منهم يضيع عمره ثم تضيع منه «تحويشة العمر» لسبب أو لآخر، وبالتالى عندما وصلت مدخراتى لـ«عشرة آلاف دولار» كانت توازى «ستين ألف جنيه مصرى» قررت العودة!
أخذت شقة إيجار فى إمبابة، ودفعت لها مقدم ٣ آلاف جنيه، ووضعت الباقى فى البنك، وكنت أريد الكتابة، وكنت أنشر مقالات فى مجلات مثل «الفيصل» و«اليمامة» وأنا فى السعودية.
وكان السعوديون يحبونى ويعزونى وكانت تعجبهم كتابتى، وعندما عدت القاهرة أكملت رواية «المسافات»، التى بدأت كتابتها فى السعودية.
■ هل واجهتك معاناة فى السعودية خلال فترة إقامتك؟
- فى الحقيقة لم تكن هناك معوقات أو معاناة سوى أننى كنت أريد تحسين دخلى، ففى لحظة فكرت أن أترك الكفيل وأنتقل لعمل آخر، لكنه رفض فقررت العودة، وتبوك كانت بلدة صغيرة ونظيفة وحلوة، وبالتالى لم أعان من الغربة، ولكن قررت العودة، وكان قرارى هو التركيز فى الكتابة، وعدم الصراع على المناصب فى الثقافة الجماهيرية، وكلما ضايقونى كنت أطلب انتدابى لهيئة الكتاب وأعمل مع سمير سرحان.
وفى سنة من السنوات كنت جالسًا مع الناقد على أبوشادى الذى كان مسئولًا عن السينما فى الثقافة الجماهيرية، فقال لى: «حسين مهران» رئيس الهيئة مضغوط عليه كى يقصيك من منصبك، ويُعين شخصًا آخر مكانك، فقلت له أهلًا وسهلًا، هات ورقة، وقدمت طلبًا بالموافقة على ندبى لهيئة الكتاب، وبالفعل أسست سلسلة «كتابات جديدة»، وكنت أول رئيس تحرير لها فى منتصف التسعينيات، وعندما حدثت مشكلة بسبب رواية «الصقار» للكاتب «سمير غريب»، فى عام ١٩٩٦، حيث هاجمه فهمى هويدى وتم تقديم بلاغ ضده لتكفيره، فبدأ يحدث نوع من التدخل والرقابة على السلسلة، فقررت الاستقالة من رئاسة السلسلة، لأنى دائمًا كنت أضحى بالمنصب أو الوظيفة، من أجل الكتابة، والسلسلة نشر فيها كتاب عظماء لم أكن أعرفهم قبل أن أنشر لهم.. فمنهم كان يقابلنى على المقهى ويقول لى ماتعرفنيش يا أستاذ إبراهيم؟؟ إنت أصدرت لى مجموعة كذا فى كتابات جديدة! فأنا كنت أحكم على الكتابة فقط بغض النظر عن شخص الكاتب.
من الناحية المادية كنت أعتمد على كتابة المقالات الصحفية، لأن الروايات لم تكن تدر عائدًا ماديًا وقتها، وكنت أكتب مقالات فى الصحافة العربية حتى أستطيع أن أعيش، ودخلنا فى الثمانينيات وتزوجت وأنجبت، وكتبت المسافات، والبلدة الأخرى، والصياد واليمام.. ورغم أنى تركت العمل السرى فإننى كنت من المؤسسين لحزب التجمع، وكنت فى لجنة الثقافة مع فريدة النقاش وكنا ننظم ندوات، فأقيمت ندوة للشاعر الفلسطينى الكبير محمود درويش، فكانت أمسية شعرية ثم لقاء معه، وبعد اللقاء سلمت عليه وعرفته بنفسى، فكان لا يعرفنى بسبب قطع العلاقات منذ أيام السادات، فكانت المجلات والصحف لا تصل هناك ولا تأتى صحف من فلسطين، فقلت له عندى رواية أريد نشرها فى «الكرمل»، فقال رواية؟ أنا عمرى ما نشرت روايات فى المجلة، فقلت له لو لم تعجبك ألقها فى القمامة، فقال تعالى لى الصبح فى الفندق، فذهبت له فى الفندق وكنا نكتب على الآلة الكاتبة وقتها، فأخذت نسخة كانت فى حدود ٧٠ صفحة، فقال لى «أنا حيوان قراءة» وسوف أقرؤها فى الطيارة، وأضاف: باقى شهرين على العدد الجديد لأن المجلة كانت فصلية، ولو أعجبتنى، فسوف أطلب من سليم بركات مدير التحرير أن يرفع بعض المواد ويضع الرواية.
فالعدد الـ١١ كان أول عدد من الكرمل يدخل مصر، وصدر العدد ودخل مصر دون أن أعرف.
وعندما كنت أسير فى الشارع وجدتها عند عم مدبولى بائع الجرائد على الأرض، وظللت أدور حولها، فقال لى يا أستاذ إبراهيم عايز إيه؟
فى النهاية تجرأت واشتريت العدد، ولكن وجدت الرواية منشورة فى مقدمة العدد، واسمى مكتوب بشكل بارز، وهذا كان تقديمًا عظيمًا لىّ على المستوى العربى، وفتح لى النشر فى الكرمل أبواب العالم العربى، فكان هذا تعويضًا عن تضييق كنت أعانى منه من مجموعات بعينها داخل مصر.
وكان هذا فى أواخر عام ١٩٨٤، فى شهر نوفمبر، وفى أوائل عام ١٩٨٥ كان موعد معرض الكتاب، وكنا فى «لجنة الدفاع عن الثقافة القومية» ننظم مظاهرة كل عام ضد مشاركة إسرائيل فتم اعتقالنا، أنا وفريدة النقاش وصلاح عيسى وعبدالخالق فاروق، وحسنى عبدالرحيم، ولطيفة الزيات، وعواطف عبدالرحمن، مجموعة من الكتاب، كنا ٢٥ كاتبًا وصدر قرار حبسنا على ذمة قضية سياسية، وخرجت من الحبس بعد ٢٢ يومًا فقط وهما كملوا، شهر حبس احتياطى، وخرجوا بقرار من المحكمة، وأذكر أن الضابط الذى اعتقلنى كان قمة فى الاحترام وامتنع عن إيقاظ أطفالى وتفتيش غرفتهم لأنه متأكد أنه لا يوجد فيها شىء، كما أنه ترك مخطوطة الرواية التى كنت أكتبها على المكتب ولم يصادرها، وأذكر أنه بعد عشرين عامًا أصبح محافظًا لإحدى المحافظات، ووجه لى الدعوة لزيارة المحافظة لكننى انشغلت ولم أذهب.
وتجربة الاعتقال كانت مهمة وكتبت عنها فى كتاب «الأيام الحلوة فقط»، كنا نسهر معظم الليل وكان بشير السباعى المثقف والمترجم العظيم ينظم لنا ندوات، فكرية، وهناك مواقف غاية فى الطرافة.. وخرجت لأستمر فى الكتابة، ولم أشغل بالى بالكسب المادى ولم أمر بأزمة مادية أيضًا، وعندما كنت أقترض مبلغًا لم أكن أجد مشكلة فى سداده أول الشهر، وعندما اعتقلت كنت أكتب «بيت الياسمين» وكان فيها مشهد يدخل فيه الضابط للقبض على البطل، ووجدت المشهد يحدث فى الواقع فضحكت، وعندما سألنى الضابط عن سبب ضحكى رويت له، فترك الرواية على المكتب ولم يصادرها، وأكملتها بعد أن خرجت، ونشرتها عام ١٩٨٦، بعد أن تم نشر «الصياد واليمام» فى «الكرمل»، وصادفت نقدًا جماهيريًا فزادت ثقتى فى نفسى، وعندما كتبت رواية «ليلة العشق والدم» عام ١٩٨٢، كتب عنها كبار النقاد وكان د. على الراعى وقتها أول من كتب عنها، وكان لهذا معنى كبير جدًا لأن النقاد المنتمين لجيل الستينيات لم يكتبوا عنى، وتجاهلوا أعمالى، لأنهم كانوا يقيمون سياجًا حول جيل الستينيات كمجموعة متجانسة ولا يسمحون لغيرهم بالدخول فيه، وبالتالى تجاهلوا أعمالى أنا والمنسى قنديل على الرغم من أننا كتبنا فى أواخر الستينيات، وأعتقد أن أفضل ما فعلته أننى لم أشغل نفسى بهم نهائيًا واستمررت فى الكتابة، وهكذا تجد أن صديقى فاروق عبدالقادر لم يكتب عنى نهائيًا، طوال حياته، ولكن فى نفس الوقت كتب عنى نقاد كبار مثل شكرى عياد وعلى الراعى وهم نقاد أقدم وأساتذة، ورغم اتجاهاتهم الاجتماعية والثقافية المختلفة عن اليسار فكان النقاد الليبراليون لديهم قيم جمالية وأخلاقية وموضوعية وليس عوامل شخصية، نفس الأمر ينطبق على كبار النقاد العرب الذين كتبوا عنى دون معرفة شخصية مثل فيصل دراج وآخرين لا يقلون أهمية.
■ هل بُعدك عن العمل السياسى أدى لإدانتك من جيل الستينيات أو لوجود تكتل ضدك؟
- بالعكس أظن أن علاقتى باليسار ظلت أقوى منهم، جيل الستينيات تم تقديمه كجيل يسارى، واستفاد من هذا ولكن فعليًا معظمهم ليست لهم علاقة بالسياسة، جمال الغيطانى كانت له تجربة قصيرة قبل ١٩٦٧، ولكن لا إبراهيم أصلان ولا محمد كشيك ولا غيرهما كانوا سياسيين، بالعكس خروجى من الحزب الشيوعى لم يمنعنى من اتخاذ مواقف معارضة ضد السادات، والتظاهر ضده، وأظن أن موقف جيل الستينيات منى كان سببه إن رواياتى كانت تنجح وتنشر فى دور نشر كبيرة وأنا ما زلت شابًا، فكنت أنشر فى المستقبل والثقافة الجديدة، والفكر المعاصر، وعندما كتبت رواية البلدة الأخرى عام ١٩٩٠، فتحت لى الأبواب، فكتبت فى كل مجلات العالم العربى الكبيرة وهم لم يتحملوا ذلك، وعبروا عنه بالرفض والحصار. وعندما تم إطلاق جائزة نجيب محفوظ فى الجامعة الأمريكية، فوجئت بأننى حصلت على الجائزة عن رواية البلدة الأخرى، ولم أكن قد تقدمت للجائزة من الأساس، وفى نفس الوقت لم يحصل عليها الأدباء الذين يجالسون نجيب محفوظ ويعتبرون أنفسهم من حوارييه، وبالتالى كان رد فعلهم أنهم أطلقوا حملة تشويه ضدى، وقالوا إنى حصلت على جائزة الجامعة الأمريكية لأنى عميل أمريكى!
فكتبت مقالًا ساخرًا قلت فيه.. هل يجوز أن أكون عميلًا بألف دولار فقط «وكانت هذه قيمة الجائزة»، وقلت لو الجائزة ألفا دولار تكون التهمة معقولة.. كنت أسخر طبعًا، والأستاذ نجيب محفوظ علق وقتها على هذا الاتهام لصحيفة الأهالى، وقال: «الاعتراض على جائزة تحمل اسمى هلوسة صحفية وقد فاز بها أديبان كبيران هما لطيفة الزيات وإبراهيم عبدالمجيد»، والاثنان لهما تأثيرهما الواضح فى الثقافة العربية، فكانت بداية علاقتى الشخصية به، وعندما كنت أذهب له فى ندواته كنت أتركها لأن الجالسين يقولون آراء ساذجة، وهو يجاملهم لأنه مجامل جدًا، فكنت أذهب إليه فى المنزل وكل سنة كنت فى شهر رمضان أزوره وأشرب معاه الشاى وأتناول قطعة من الجاتوه وأمشى، وفى كل حواراته يقول أنا لم أقرأ بعد إصابتى إلا لإبراهيم عبدالمجيد، لأنه يكتب بالألوان الأزرق والأصفر، وأنا عمرى ما تاجرت بهذه الحكاية.