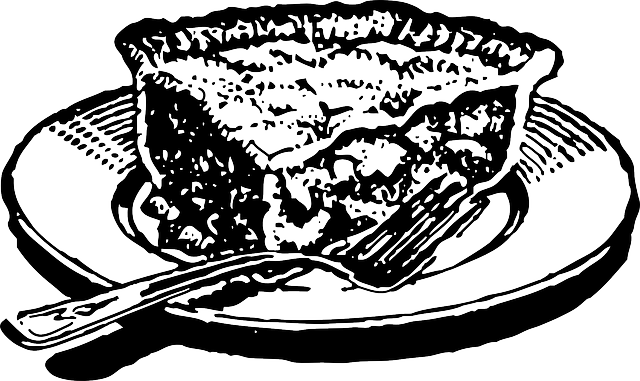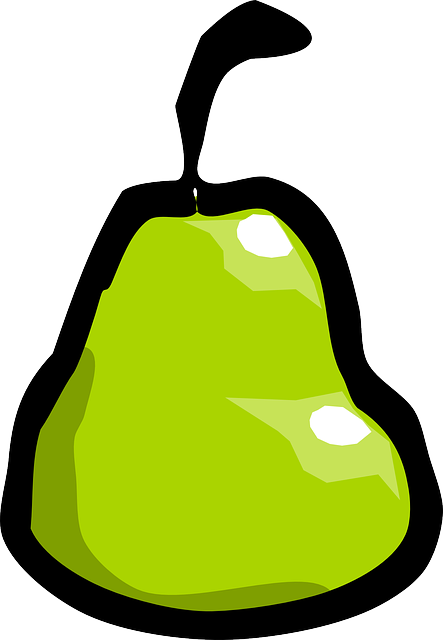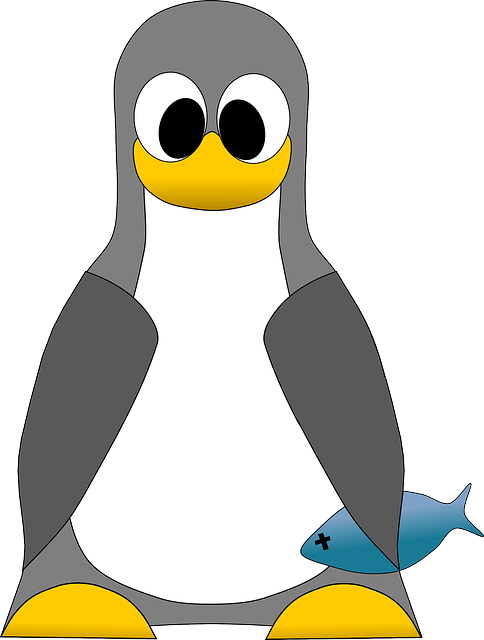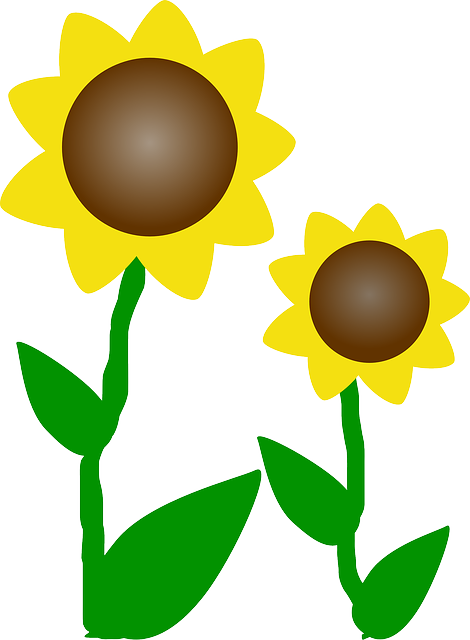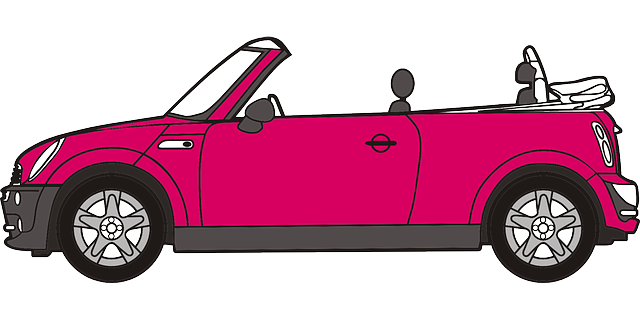اÙجدÙد Ù٠أ٠اÙسعÙدÙØ© تسع٠٠٠خÙا٠Ùذا اÙÙش٠اÙجدÙد اÙذ٠ظÙر ÙÙاÙØ© عا٠2021 Ø¥Ù٠ا٠تÙا٠تÙÙÙÙÙجÙا صÙاعة ÙتطÙÙر Ùذ٠اÙصÙارÙØ® عÙ٠أراضÙÙا بدÙا٠٠٠استÙرادÙا ٠٠اÙصÙÙ Ù٠ا ÙعÙت ÙÙ ÙÙت سابÙ. ÙÙ٠اÙÙÙت اÙØ°Ù ÙØ«Ùر Ùذا اÙÙش٠اÙÙØ«Ùر ٠٠اÙجد٠Ù٠أÙساط عدÙدة Ø¥Ùا Ø£ÙÙ Ùد ÙÙÙÙ Ùرصة ÙÙتÙصÙ٠إÙ٠اتÙاÙÙØ© Ø¥ÙÙÙÙ ÙØ© ٠تعددة اÙأطرا٠ÙÙØد٠٠٠اÙتشار أسÙØØ© اÙد٠ار اÙشا٠Ù.
عÙ٠٠دار سÙÙات تدÙر بÙ٠أÙÙÙ ÙÙÙتÙÙ Ù٠اÙØ®ÙÙج اÙعرب٠اÙسعÙدÙØ© ٠٠جÙØ© ÙØ¥Ùرا٠٠٠جÙØ© أخر٠Øرب باردة Ùسبا٠تسÙÙØ Ùا ÙØ®Ù٠عÙ٠أØد. تعززت Ùذ٠اÙÙ ÙاجÙات بعد اØتدا٠اÙصراع بÙÙÙ٠ا عÙ٠اÙأراض٠اÙÙÙ ÙÙØ© Ù Ù Ø®Ùا٠اÙØرب اÙت٠تخÙضÙا اÙسعÙدÙØ© ÙÙÙÙاء Ø¥Ùرا٠Ù٠اÙÙ٠٠اÙ٠ت٠ثÙØ© بج٠اعة اÙØÙØ«Ù. ÙÙÙ ØÙ٠أ٠Ùذ٠اÙتÙاÙس اÙØ¥ÙÙÙ٠٠بÙ٠اÙجارتÙÙ Ùا ÙÙ Ù٠عزÙ٠ع٠٠سار اÙتÙاÙس اÙدÙÙ٠بÙ٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة ÙØÙÙائÙا ٠٠جاÙب ÙبÙ٠إÙرا٠٠٠جاÙب Ø¢Ø®Ø±Ø Ùإ٠أ٠٠ØاÙÙØ© ÙÙضع Øد٠ÙÙذ٠اÙØرب اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ© اÙباردة ÙÙ ÙتØÙ٠إÙا عبر Ø¢ÙÙØ© ٠تعددة اÙأطرا٠ÙÙÙÙ٠اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ© اÙÙ Ùخرطة.
ÙÙÙعتبر Ùضع Øد٠ÙÙذا اÙتÙاÙس اÙخش٠بÙ٠اÙسعÙدÙØ© ÙØ¥Ùرا٠أØد Ø£Ù٠أع٠دة اÙأ٠٠اÙØ¥ÙÙÙÙ Ù. بÙÙÙ Ø© أخرÙØ ÙØ¥Ù Ù ÙØ·ÙØ© اÙشر٠اÙØ£Ùسط ÙاÙØ®ÙÙج Ù٠تÙع٠بÙÙع ٠٠اÙاستÙرار ÙاÙازدÙار دائ٠ÙÙ٠٠ا ÙÙ Ùت٠اÙتÙص٠إÙÙ Ù Ùاربة تÙÙÙ Ùذ٠اÙØرب اÙباردة بÙÙÙ٠ا. Ùإذا Ùا٠٠٠اÙÙ Ùط٠أ٠ÙتØÙÙ Ùذا اÙأ٠ر Ù Ù Ø®Ùا٠ÙÙÙات دبÙÙ٠اسÙØ© ٠باشرة بÙ٠اÙرÙاض ÙØ¥Ùرا٠ÙØ٠اÙØ®ÙاÙات بÙÙÙ٠ا ÙاÙÙصÙ٠إÙ٠صÙغة ÙÙعÙØ´ اÙسÙ٠٠اÙ٠شترÙØ Ùإ٠جÙÙدا٠دÙÙÙØ© بÙÙادة اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة تÙعتبر Ø£Ùضا٠جÙÙرÙØ© ÙÙ Ùذا اÙصدد. ÙÙÙÙ Ùذا ÙØتاج Ø¥ÙÙ Ù Ùاربة Ø£Ùثر Ø´Ù ÙÙا٠تتعد٠٠جرÙد اÙتÙÙÙØ Ø¨Ùرض ٠زÙد ٠٠اÙعÙÙبات عÙ٠إÙراÙ. ÙÙÙا٠Øاجة Ø¥Ù٠اÙتÙص٠إÙ٠صÙغة تط٠ÙÙات ٠شترÙØ© بÙ٠ج٠Ùع اÙأطرا٠ÙØ°Ù٠عبر ٠راعاة ضرÙرات اÙأ٠٠اÙÙÙÙ Ù ÙÙ٠طرÙ.
ÙÙا٠٠٠Ùر٠أ٠سع٠اÙسعÙدÙØ© Ø¥Ù٠تطÙÙر برÙا٠جÙا ÙÙأسÙØØ© اÙباÙÙستÙØ© سÙÙ ÙزÙد Ù Ù ØدÙØ© سبا٠اÙتسÙÙØ Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© خصÙصا٠٠ع Ø¥ÙراÙØ ÙباÙتاÙÙ Ùضع أ٠٠اÙÙ ÙØ·ÙØ© ÙÙÙا عÙ٠اÙÙ ØÙÙ ÙÙ٠اÙØ°Ù ÙعاÙ٠باÙأص٠٠٠Ùشاشة ٠ز٠ÙØ©. Ùبد٠Ùذا ÙÙÙÙÙØ© اÙØ£ÙÙ٠صØÙØا٠ÙÙغاÙØ©Ø Ù٠٠شأ٠Ùذ٠اÙصÙارÙØ® ÙÙ Øا٠ØصÙت عÙÙÙا اÙسعÙدÙØ© أ٠تÙÙب Ù ÙازÙ٠اÙÙÙÙ ÙصاÙØ Ø§ÙرÙاض ÙØÙÙائÙا بشÙÙ ÙبÙØ±Ø Ø§Ùأ٠ر اÙذ٠سÙ٠تر٠ÙÙ٠إÙرا٠تÙدÙدا٠جÙÙرÙا٠ÙØ£Ù ÙÙا اÙÙÙÙ Ù.
تر٠إÙرا٠أ٠٠خاÙÙÙا ÙÙ Ùذا اÙصدد ٠شرÙعة. ÙÙ ÙازÙ٠اÙÙÙÙ Øت٠٠٠غÙر أ٠تØص٠اÙرÙاض عÙ٠اÙصÙارÙØ® اÙباÙÙستÙØ© ت٠ÙÙ ÙصاÙØ Ø§ÙسعÙدÙØ© بشÙÙ ÙبÙر. ÙاÙرÙاض تت٠تع بتدÙÙÙ ÙبÙر ÙÙسÙØ§Ø Ø§Ù٠تطÙر ÙاÙذ٠تشترÙ٠بشÙ٠دÙر٠٠ÙÙ ÙÙÙÙ Ù Ù٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة ÙبرÙطاÙÙا ÙÙرÙسا ØÙØ« تعتبر اÙسعÙدÙØ© Ø£Ùبر ٠ستÙرد ÙÙسÙØ§Ø Ù٠اÙعاÙÙ . ÙبÙ٠عا٠٠2016 Ù2020 بÙغت Ùسبة Ùاردات اÙسعÙدÙØ© ٠٠صادرات اÙسÙØ§Ø Ø¹Ø§ÙÙ Ùا٠٠ا ÙÙرب Ù Ù 11 Ù٠اÙ٠ئة. عÙاÙØ© عÙÙ Ø°ÙÙØ ØªÙ ÙÙÙت اÙرÙاض ٠٠تعزÙز ÙدراتÙا اÙضاربة بعÙدة اÙ٠د٠بشÙÙ ÙبÙر Ù Ù Ø®Ùا٠إضاÙØ© 91 طائرة Ù ÙاتÙØ© ٠٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØØ¯Ø©Ø Ù15 ٠٠برÙطاÙÙØ§Ø Ø¥Ù٠سÙاØÙا اÙجÙÙØ Ù٠ا اشترت Ø£Ùضا٠14 Ùظا٠دÙاع جÙ٠إضاÙÙ. ÙÙبÙÙ ÙÙاÙØ© عا٠2020Ø Ø´Ù Ùت ٠شترÙات اÙرÙاض ٠٠اÙأسÙØØ© Ø£Ùضا٠سبعة Ø£Ùظ٠ة صÙارÙØ® أ٠رÙÙÙØ© ٠ضادة ÙÙصÙارÙØ® اÙباÙÙستÙØ©.
Ù٠اÙÙ ÙابÙØ Ùإ٠٠شترÙات Ø¥Ùرا٠٠٠اÙسÙØ§Ø Ù٠تتجاÙز Ùسبة 3 Ù٠اÙ٠ئة ٠٠صادرات اÙسÙØ§Ø Ø§ÙعاÙÙ ÙØ©. Ùإذا أخذÙا بعÙ٠اÙاعتبار اÙعÙÙبات اÙت٠تتعرض Ø¥ÙÙÙا Ø¥Ùرا٠٠ÙØ° اÙØ«Ùرة اÙإسÙا٠ÙØ© ÙØ¥ÙÙا Ùا ÙÙ Ù٠أ٠تØص٠عÙ٠أ٠طائرات أ٠أÙظ٠ة دÙاع جÙ٠٠تطÙرة ٠٠اÙغرب. Ùذا ÙضÙا٠ع٠أ٠Ùذ٠اÙعÙÙبات Ùد جعÙت ٠٠اÙصعÙبة اÙÙبÙرة عÙ٠إÙرا٠استÙراد أ٠إÙتاج Ùطع اÙغÙار اÙت٠تØتاجÙا ÙÙØÙاظ عÙ٠أسطÙÙÙا اÙÙدÙ٠٠٠اÙطائرات أ٠اÙÙرÙاطات اÙت٠ÙاÙت ØصÙت عÙÙÙا ٠٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة إبا٠ØÙ٠اÙشا٠اÙØ°Ù Ùا٠ÙÙعتبر ØÙÙÙا٠ÙÙÙا٠ÙÙاشÙØ·Ù Ù٠تÙ٠اÙÙترة.
ÙباÙتاÙÙØ Ùإ٠إÙرا٠ÙÙ٠ظ٠اختÙا٠٠ÙازÙ٠اÙÙÙÙ ÙØ°Ø§Ø ØªØرص عÙ٠تطÙÙر برÙا٠جÙا اÙصارÙخ٠ÙتØÙÙÙ ÙÙع ٠٠اÙردع اÙ٠تبادÙ. ÙÙد أثار برÙا٠جÙا اÙصارÙخ٠جدÙا٠Ùاسعا٠عÙ٠اÙ٠ستÙ٠اÙدÙÙÙ ÙÙ٠٠ا دÙع إدارة اÙرئÙس باÙد٠إÙ٠اÙتشدÙد عÙ٠تض٠ÙÙ٠إÙ٠أ٠اتÙا٠Ùاد٠بÙ٠إÙرا٠ÙاÙÙÙ٠اÙÙبر٠ØÙ٠برÙا٠جÙا اÙÙÙÙÙ. ÙÙ Ù ÙاÙÙØ© اÙÙÙ٠اÙتذÙÙر إ٠تخÙ٠اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙ٠٠٠برÙا٠ج Ø¥Ùرا٠اÙصارÙخ٠ÙعÙد Ù٠جزء ÙبÙر Ù Ù٠إÙ٠برÙا٠جÙا اÙÙÙÙ٠بØد ذاتÙ. ÙÙÙا٠تخÙ٠أ٠تÙÙ٠إÙرا٠Ùادرة عÙ٠تØÙ ÙÙ Ùذ٠اÙصÙارÙØ® بعÙدة Ù٠تÙسطة اÙ٠د٠رؤÙسا٠ÙÙÙÙØ© ÙÙ Øا٠تÙص٠إÙ٠صÙاعة اÙÙÙبÙØ© اÙÙÙÙÙØ© ÙاÙت٠تÙعد٠Ùاب ÙÙسÙ٠أ٠أدÙÙ Ù ÙÙا Øسب تÙدÙرات ÙÙعدÙد ٠٠اÙأجÙزة اÙاستخباراتÙØ©.
اÙÙÙÙ Ø Ùأ٠ا٠ØÙائ٠اÙتسÙÙØ Ø§ÙجدÙدة ÙØ°ÙØ Ùإ٠اÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة ÙÙ Ù Ø®ÙÙÙا اÙ٠جت٠ع اÙدÙÙ٠أ٠ا٠Ùرصة ٠٠أج٠اÙتÙص٠إÙÙ Ù Ùاربة جدÙدة بخصÙص اÙأ٠٠اÙÙÙÙ Ù. ÙÙ Ù Ø®Ùا٠٠Øادثات ÙÙÙÙا ØÙ٠برÙا٠ج Ø¥Ùرا٠اÙÙÙÙ٠تستطÙع ÙاشÙط٠استخدا٠برÙا٠ج اÙسعÙدÙØ© اÙصارÙخ٠ÙÙرÙØ© ضغط عÙÙ Ø·Ùرا٠ÙÙتخÙ٠ع٠برÙا٠جÙا اÙصارÙخ٠ÙØ°Ù٠عبر Ø¥ÙÙاع اÙجاÙبÙ٠أ٠٠صÙØتÙ٠ا ÙÙ Ù٠أ٠تتØÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠تخÙÙض اÙتسÙÙØ ÙاÙتÙص٠إÙ٠اتÙاÙÙØ© ٠تعددة اÙأطرا٠تÙعÙ٠بشÙ٠أساس٠ب٠راعاة اعتبارات اÙأ٠٠اÙÙÙÙ Ù ÙÙ٠اÙÙÙ٠اÙØ¥ÙÙÙÙ ÙØ© اÙÙ Ùخرطة Ù٠اÙأز٠ة ÙتخÙÙاتÙا. ÙÙرÙØ© اÙتخÙ٠اÙ٠تباد٠ع٠برÙا٠ج اÙصÙارÙØ® اÙباÙÙستÙØ© ÙÙ Ù٠أ٠تÙÙÙ ÙرÙØ© رابØØ© بÙد إدارة باÙد٠ÙتØصÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© اÙشر٠اÙØ£Ùسط ضد اÙتشار أسÙØØ© اÙد٠ار اÙشا٠ÙØ ÙÙ٠٠ا ÙتÙاء٠بشÙ٠عا٠٠ع سÙاستÙا اÙدÙÙÙØ© بÙذا اÙإطار.
٠٠شأ٠ÙÙذا اتÙا٠أÙضا٠أ٠Ùضع Øدا٠Ùتدخ٠ÙÙ٠أخر٠٠عÙÙØ© ببÙع Ù ÙظÙ٠اتÙا ٠٠اÙأسÙØØ© اÙاستراتÙجÙØ© اÙ٠تطÙرة ÙاÙصÙÙ ÙرÙسÙا. ÙاÙÙÙاÙات اÙ٠تØدة ٠عÙÙØ© Ø£Ù Ùا تتØÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© اÙØ®ÙÙج Ø¥Ù٠٠ستÙدع ÙÙأسÙØØ© اÙاستراتÙجÙØ©Ø Ø§Ùأ٠ر اÙذ٠٠٠شأÙ٠أ٠ÙÙدد ٠صاÙØÙا اÙاستراتÙجÙØ©. ÙÙا٠Øرص ÙØ§Ø¶Ø Ù Ù Ø§ÙصÙ٠عÙ٠اÙاÙتشار Ø£Ùثر ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© اÙشر٠اÙØ£Ùسط Ù Ù Ø®Ùا٠عÙÙد بÙع اÙسÙاØØ ÙاÙأ٠ر ÙÙطب٠أÙضا٠عÙ٠رÙسÙا بÙا Ø´ÙØ ØÙØ« تØاÙ٠إÙرا٠اÙØصÙÙ Ù ÙÙا عÙÙ Ù ÙظÙÙ Ø© S-400 ÙÙدÙاع اÙجÙ٠اÙ٠تطÙرة. ÙØ٠أ٠ا٠Ùرصة ÙÙضع Øد Ùسبا٠اÙتسÙØ Ù٠اÙÙ ÙØ·ÙØ©Ø ÙبرÙا٠ج اÙسعÙدÙØ© ÙÙصÙارÙØ® اÙباÙÙستÙØ© رب٠ا ÙÙÙ٠شرارة اÙبدء إذا Ùا٠ÙÙا٠ÙÙØ© سÙاسÙØ© جادة Ùد٠اÙأطرا٠اÙسÙاسÙØ© اÙ٠عÙÙØ©.
جÙ
Ùع اÙÙ
ÙاÙات اÙÙ
ÙØ´Ùرة تعبÙر ع٠رأ٠ÙÙتÙابÙا ÙÙا تعبÙر باÙضرÙرة ع٠TRT عربÙ.